|
إصدارات
قام
بقراءتها: حاتم الصكر
شعر
أكثر من اللازم
( ) )
في الديوان الجديد للشاعرة سوسن العريقي «أكثر من اللازم» الثاني بعد
ديوانها «مربع الألم» الصادر عام 2004، نجد رغبة معلنة بالتجاوز، تمثلها تلك
الأبيات المقتطعة لتكون إعلاناً عن هوية الديوان على غلافه الأخير:
سأغادر كل شيء
حياتي المتوارية خلف الأبواب
صوتي الذي لا أسمعه
إحساسي المتجمد
منذ اللحظة الأولى
أحلاماً مغلقة على حزنها
وأغنيات شربت
دموعي كلها.
وذلك يندرج في القراءة النسوية المحتكمة إلى ما تتعرض له المرأة من إكراهات
وضغط، كنوع ذي دور اجتماعي محدد، لا يعكس بالضرورة تجربة أو وضعاً خاصاً
بالشاعرة، بل لأن تجربتها تسعى لتلامس أفق الوجود النسوي الذي تحسه وتتمثله
بوعيها؛ فالرغبة بالمغادرة، كتعبير رديف للتجاوز، يتسع مداها ليشمل الحياة
كلها: تلك المتوارية خلف الأبواب، كناية عن الحجز والنبذ الذي يمثله إقصاء
المرأة كوجود مستقل، وصوتها الذي –لضعفه وتجاهله– لا تكاد تسمعه هي ذاتها. وإلى
جانب الحياة والصوت ثمة الإحساس الموصوف بالتجمد، والأحلام المغلقة على الحزن،
والأغنيات الدامعة.
وهذا الوعي ينقل التجربة العاطفية كذلك إلى فضاء المساواة والندّية
والتخاطب مع الرجل كشريك، لا كمالك أو مستحوذ، وبذا يكون مخاطباً مباشرة في
أغلب القصائد. كما أنه في إهداء الديوان منكشف ومعروف. بينما تظل (هي) غير
معروفة حتى من نفسها:
إليكَ..
وأنا أعرفك.
إليّ...
ومحاولاتي لأن أعرفني.
هذا هو عقد القراءة الذي تقدمه العريقي للقارئ: شعراً أكثر من اللازم، في
تدفق المشاعر والأحاسيس والأحلام، ومحاولة معرفة الذات. وفي قصيدة الديوان
الرئيسة، التي أخذ عنوانها، تقدم الشاعرة ما يشبه التبرير لموقف يتفرع عن البحث
لمعرفة النفس:
حينما أسمح لنفسي
أن أكون نفسي
أتفاجأ
بأن الورد على الشرفة
تبسّم
أكثر من اللازم.
وتغدو عبارة: «أكثر من اللازم» لازمة تختم الفقرات التي ترصد ما يحصل.
فالقمر اقترب أكثر من اللازم، والليل كذلك. لذا تقرر الشاعرة:
أن أكون نصف نفسي
حتى لا أحس الأشياء
أكثر
من
اللازم.
وذلك يؤكد ضرورة قراءة الديوان نسوياً للتعرف على الوعي المخبوء بقصديّة
يكشفها تأويل الملفوظ ومتابعة اللغة الشعرية والصور المتجلية عنها.
الشاعرة توغل -في هذا الديوان- في تجربة قصيدة النثر، التي بدأت، بها
وميّزت صوتها ضمن جيلها من الشاعرات والشعراء المنصرفين إلى الحداثة دون تردد،
وكإعلان عن الرفض والرغبة في التغيير والحلم بالحياة الإنسانية المفتقدة
واقعاً.
كما تتميز في هذا الديوان بتصميم قصائدها ضمن مخطط إيقاعي يرتكز إلى
التكرار والمقطعية، للانتقال دلالياً إلى حركة النص اللاحقة وتجميع أفقه لتصل
مضامينه ورؤاه. وهذا واضح مثلاً في قصائد مثل: «لا يعد أصابعه»، حيث يبدأ
المقاطع الثلاثة على التوالي بعبارات: يا للوحشة! يا للدهشة..! يا للفجيعة!...
وقصيدة «اكتشاف»، التي تعلو مقاطعها على التوالي عبارات: أرحل عنك، أرحل
إليك، أتغلغل فيك، أعانق فيك...
ولم ينجُ بعض قصائد الديوان من القرب من العامية التي تسود أجواء كثير من
قصائد النثر المكتوبة هذا الأيام بإغراء الاسترسال والتبسط اللذين تتيحهما
البنية النثرية المتخففة من الإيقاعات الصاخبة والوزنية التي هجرتها القصيدة
النثرية؛ كقصيدتيها: «رمضانية»، و»إجهاض».
وإذا كان الديوان لا يعكس في هذه العاصفة الشعرية، المندفعة أكثر من
اللازم، في إطار البوح والشكوى العامة والرغبة في التجاوز، أية مراجع ثقافية أو
معرفية يحال إليها القارئ لتعزيز الملفوظ بـ»التناص»، وكذلك ندرة الصور
والتشبيهات، فإن الانزياح ينشط شهية المقارنة والعدول عن المعاني المتوقعة
ودلالاتها قبل الانزياح عنها إلى ما أخذته بعد تغييرها؛ مثل:
ترميه بوابل... من صراخ
ذات... يأس
الأحلام الأمّارة... بالمستحيل
النفس الأمّارة... بالمستحيل.
(سوسن العريقي: أكثر من اللازم (شعر).
صنعاء. ط1. 2007)
دم العراقيين على ثرى وطن مبتلى
العنوان الطويل لديوان الشاعر والكاتب الدكتور علي حداد «وقت مستقطع من
الخلاف الاستراتيجي على دمنا» يعكس -لا شعورياً- طول المأساة العراقية القائمة
منذ بدء الاحتلال ونزف الدم على ثرى بلاد الرافدين، التي يدفع أهلها ثمن
امتدادهم الحضاري والمدني وأصالة وطنهم المستباح.
قصائد الديوان العشر تؤكد المعاناة وترصد مفرداتها الدامية، ولكنها لا
تستسلم لليأس؛ فالاحتلال إلى زوال، والموت الذي يعربد في الطرقات مجانياً
ومجنوناً سوف توقفه إرادة العراقيين، التي أوقفت قبله موجات المغول وكابوسهم
الذي ظل قروناً.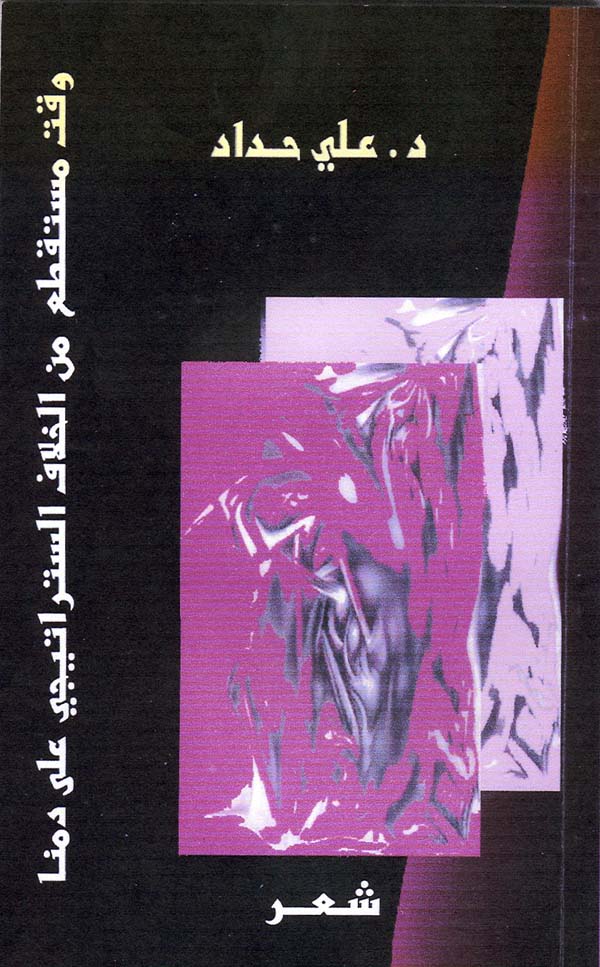
تحتشد في الديوان ذاكرة حية لشاعر عراقي يحمل الوطن معه في اغترابه المؤقت
والاضطراري، ويعزز رؤاه بالتضمينات والاستشهادات الشعرية التي يفتتح بها
الديوان، ويعلوها بوح الأعشى بشوقه الذي أسنده لرواحله المتشوّقات «وهمّهنَّّ
العراقُ»، والاقتباس عن محمود درويش «الشعر يولد في العراق». ولعل هذا أحد أبرز
أسباب الخلاف على دمنا المهدور، بما تكتنزه الروح العنقائية للعراقيين في مسلسل
الدمار والعسف والموت المتكرر على أرضهم.
الوزنية التي لازمت القصائد بحدة تعكس جانباً من توتر الملفوظ الشعري نفسه،
والضغط الهائل الذي تركته المعاناة العراقية القائمة تحت نير احتلال أمريكي،
وعنف أعمى متولد عنه ينال أرواح الأبرياء بلا رحمة.
دعونا!
وهذا الغريب الذي جاء يحتلنا
بمقدار ما يحتسي من كؤوس رعونته
ويبصر ميراث أجدادنا الفقراء،
«فالاتهم»
في حنايا الذين أتوا قبله..
ومدافع أسلافه قضمتها الحشائش
والوحشة الباردة.
لقد جاء ديوان علي حداد ثالثاً في سلسلة دواوينه، فضلاً على دراساته
النقدية وأبحاثه. ويُلاحظ أن العراق وأوضاعه المأساوية القائمة كانت تشغله فيها
جميعاً. وسنلاحظ أن العنوان المطول لديوانه هو تأكيد لما سبق في عناوين سابقة؛
فثمة إحساس داخلي ينعكس في العنونة يريد أن يوصل طول تلك المعاناة العراقية
وملحميتها والزمن الذي تستغرقه في الواقع والوجدان معاً.
يسبق المقتطفات الشعرية عن العراق أبيات منفردة كمدخل يقول فيها السياب:
فيا ألق النهار
اغمر بعسجدك العراق
فإن من طين العراق
جسدي ومن ماء العراق.
فالصلة بالعراق إذن شعرية في المقام الأول، لا بالانتماء الدموي. وربما كان
هذا ما جعل الديوان كصرخات في وجه الدمار الذي يلحق بالوطن. وكما بدأ الديوان
بالعراق فقد انتهى به في آخر أبياته، ولكن بِرِهان متفائل يخفف من عتمة
الكابوس، ويفتح كوة من أمل بشفاء الجسد العراقي الطعين.
ولو بعد حين من الصبر
وحين من الجمر
وحين من الصبر والجمر والاحتراق
لسوق يجيء..
على شفتيه مرايا من الائتلاق
لسوف يجيء العراق.
هذا التفاؤل ليس تمنيات عابرة، بل يقين يحتكم إلى ما يحيط به الديوان من
عمق حضاري ومعرفي في هذا الوطن، ومن وطنية أبنائه الذين تجاوزوا محناً أشد،
وأزاحوا غزاة وطغاة كثراً عبر التاريخ. لذا كان غاضباً حين رد على شاعر عراقي
يقول إنه لم يعد العراق إلا مكان ميلاده فقط، وليس وطناً كاملاً! ويناقشه
شعرياً بالقول:
لو نزعنا العراق كثوب تهرأ
أيَّمَا وطنٍ سوف تلبس أعمارنا
وتقول: اكتسيت؟!
أي كأس ستشرب هذا الخراب
الذي يتكاكأ في دمنا
وتقول: ارتويت؟!
أي مقبرة سوف تحمل أكفاننا
وتقول: أنا البيت؟
هذا الإحساس الحاد بالفجيعة جعل القصائد تستقصي ميراث الوطن حزناً وجمالاً،
تاريخاً وحاضراً. فالشاعر لا يتوقف عند أطلال وطن يتهدم، بل يبكي حاضراً يتهشم
تحت سمع العالم وبصره. لذا يستمد موضوعاته من الحاضر أيضاً، فتستوقفه جريمة
احتراق شارع المتنبي، بمكتباته الشهيرة، ووجوده كعلامة على ثقافة يريد
الأمريكان والغلاة أن يجعلوها خراباً كي لا تنير في ظلام وطن مستباح.
فيكتب علي حداد نصاً ممسرحاً يستعين بالأصوات وحواراتها ومرائيها، ليجسد
مأساة احتراق الشارع الذي اقترن باسم الشاعر، فجاء به ليشهد على الجريمة.
يجمع المتنبيّ أشلاء شارعه
ونثار الزمان المسجى
وحكايات موتٍ نكررها
وموت يكررنا
ويغادرنا ممعناً في الأسى!
وكان الطابع الثقافي للشارع وتاريخه مناسبة ليستعيد الشاعر -عبر الأصوات
المتحاورة درامياً- علامات مضيئة من ثقافة العراق ومثقفيه، شعراء وفنانين.
لقد توازت لغة الديوان المتوترة، واستعانات الشاعر بالنصوص والإشارات
والإحالات، مع نبرة الديوان العالية، كإيقاع لا بديل سواه لعرض مأساة كالتي تحل
اليوم بالعراق. وجهد الشاعر يمثل موقف الشاعر العراقي الرافض للاحتلال البغيض
وتداعياته المتنوعة عنفاً ونفياً وخراباً.
(د.
علي حداد: وقت مستقطع من الخلاف الاستراتيجي على دمنا (شعر). مكتبة المتفوق - صنعاء، 2007)
القرين الذي في الخارج
الشاعر اليمني طه الجند محسوب -فنيا ورؤيوياً- على أصوات الجيل المتصعلك،
الذي يفاكه الحياة ويعابثها ألماً وحزناً، ويشكو فاقته وجدب حياته بدعابات
ظاهرها فكاهي لكنها متألمة، وعدوى ألمها تسري إلى المتلقي بسهولة، شعراً. بلا
حذلقات لغوية أو موضوعات كبرى، قصائد تكنس الأرض وتلم ترابها لتعلو به وتصيره
شعراً. أحداث لا تستوقف أحداً، وأسماء لهامشيين وهامشيات وأمكنة منزوية ومنتبذة
وأصحاب صعاليك، وحياة مدمرة بالبؤس والخسران والعوز، تلك هي أبرز مرتكزات
الخطاب الصعلوكي الجديد أو المعاصر، الذي وجدنا له ملامح متلونة في شعر رائد
هذا اللون في شعر الحداثة في اليمن: عبدالكريم الرازحي، ثم في شعر محمد اللوزي
وعلي الشاهري، وآخرين من الأجيال التالية وبدرجات متفاوتة.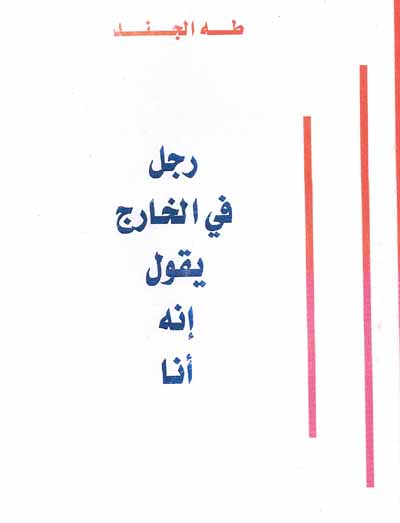
هنا لم ينجُ الشعر من الحشو والتكرار، ولا من الشعبوية الواضحة في المفردات
والتراكيب أو الجمل الشعرية. وربما كان النثر في قصيدة النثر مشجعاً على ذلك
فنياً، ولكن حدود الرؤية هنا ذات أثر كذلك في هذا الطابع الشعبوي، ويمكن
ملاحظته في إلقاء هؤلاء الشعراء وتلفظاتهم، كما في الصور والصيغ والإيقاعات.
الجَنَد في ديوانه الثاني «رجال في الخارج يقول إنه أنا»، يعيد مسألة
القرين ثانية، ولكنه هنا منفرد عنه ومغترب، كنايةً عن الاغتراب عن النفس ذاتها.
وتترجم القصائد، المتسمة بالقصر والتكثيف، هذا الإحساس بالخوف من الخارج وحتى
من القرين نفسه.
في حيز لا يكفي نملة
أفكر وأزحف
أقامر وأدور
أفرح وأحزن
أشيخ وأموت... (قصيدة «أنا»).
كما يتساءل في قصيدة أسبق:
أسأل أنا عن طه الجند
مَن عساه يكون هذا طه الجند؟
ولعل المفتتح المأخوذ من حكاية الحيوان (لا تطلب العون ممن يتفنن في الأذى)
يؤكد ذلك النبذ والإقصاء والتباعد عن الجماعة، مما يكرس العزلة والخوف من كل
شيء في الخارج، حتى من النفس، «من رجل في الخارج يقول إنه أنا». وهو ضد
الجماعة، لأنه واضح وهم في الخفاء، لذا يتعلق بأشياء القرية ورؤاها كخلاص. كما
يستعين بقصائد النثر تكريساً للمخالفة والخروج، شأن شعراء الصعلكة العرب
(نستذكر هنا «جان دمو» العراقي وقصائده المبتورة القصيرة التي تنتهي فجأة
انعكاساً لملله وكسله) كما يعيد الجند أجواء ماغوطية توضحها قصيدة «ما يجمعنا»
كمثال.
لا نحن فقراء بما يكفي
ولا أنتم أثرياء كما يجب
ما يجمعنا هو الغبن
دعوا لنا إذاً شيئاً من الرصيف
ستدركون كم نحن مهذبون
حين نمد أيدينا مثلكم بسلاسة
للمحسنين!
هذه القصيدة التي تعمدت إيرادها كاملة تلتقي بشعر محمد الماغوط في تساؤلاته
عن عدل مفقود وتباين في العيش، وفي انقسام العالم نصفين كما توضح قصيدة الجند.
فالماغوط يرتكز في شعريته على تساؤلات تنبه إلى ما في العالم من انقسامات
تسم حياة البشر وتباعد بينهم: أغنياء وفقراء. وتساعد هذه القناعة على انتهاج
بساطة آسرة، ومحاججة طريفة، كالتي شرع الجند في إقامتها هنا، مفترضاً أن
الأثرياء هم بدورهم فقراء لأشياء كثيرة يتساوون فيها مع الفقراء ويمدون أيديهم
معهم للمحسنين.
القرية برعاتها وبسطائها وطبيعتها تحضر كلما نهشت المدينة الشاعر بأنياب
الجوع أو الوحدة والعوز والانتظار لما سيجيء. كما تختبىء الدلالات الجنسية كجزء
من بنية الحرمان، كما في قصيدة «كلب خديجة» الذي يكني به عن الرغبة وتوسلاته
لإسكات هيجاناتها، عبر إسقاط نباح الكلب على عواء الرغبة، ومناشدة الشاعر
لإسكات نباح الكلب كي تنام صاحبته!
ويرسم الجند صورة جانبية للبيت تمر عبره كأب وزوج، وهوس الأبناء وضجر
المرأة. وهذا محرق فني وفكري يجدر بنا دراسته في خطاب الصعلكة الحديث، حيث يكون
الصعلوك أباً برِماً يبحث عن وحدته وسط ضجيج البيت وضيقه (وهذه إشارة نفسية إلى
الضيق بالرابط الزوجي أصلاً) وتكون الطبيعة هي الملاذ: أرضاً وناساً وكائنات
وأجواء. أو يكون البديل هو الغوص في القاع لالتقاط الوجوه والأشياء، ثأراً من
الواقع ومشاكسةً للسائد.
والتداعيات لا تنتهي ولا يراد لها أن تتوقف. وتحس في لحظة أن الشاعر يمكن
أن يظل يعد المفردات إلى ما لا نهاية، كما في قصيدة «الوحدة»! التي ترصد مسميات
متباينة من مظاهر الوحدة سياسياً واجتماعياً. وتختلط الوحدة بمعانيها المتعددة
حتى تعني التوحد أيضاً. لذا تتسع القائمة لسياسيين كما لهامشيين في بيئة
الشاعر، وبطرافة تستفيد من المفارقة.
كم أنت وحيد أيها الصيف!
كم أنت وحيد أيها المطر!
كم أنت وحيدة يا أمي في ذمار!
كم هي وحيدة تلك الثكنات!
كم هي وحيدة رائحة النعناع!
كم أنت وحيدة يا نحلة دوعن!
يا زهرة الرمان في صعدة!
يا قلعة الدن في وصاب!
وفي القصائد «أوقفوا» و»كشف أولي بالمعيدين» و«الصافية»، يراكم الشاعر
مفردات وأسماء يبعث تنضيدها واصطفافها في النص على السخرية، لكن الدلالة تصب في
تقاطع الشاعر وتناقضه مع السائد ورفضه له.
الشعبويات والعاميات والتفاصيل الزائدة والتكرار، ربما أخذت من جماليات
النصوص. لكن حضور الشاعر في موضوعاته –رغم تباين ضمائر الخطاب للذات والآخر
وتبدلها، مما يربك القارئ ويقطع تسلسل قراءاته– جعل القصائد أكثر قرباً
وحميميةً، وقام الإسقاط المقصود من الشاعر
-عبر حضوره في موضوعاته كلها- بتلوين اللوحات الشعرية بالطابع الذاتي. لذا
يقدم الشاعر المدن كما يراها لا كما هي عليه (عدن مثلاً)، كما يفعل ذلك في
الصور الشخصية للأعلام والأصدقاء والشعراء (المقالح والبردوني وفخري وأحمد ناجي
وغيرهم...).
(طه الجند: رجل في الخارج يقول إنه أنا (شعر).
طباعة دار نجاد - صنعاء، 2008).
تلدني كلماتي
«الكتابة مناورة حية». هكذا يصف الشاعر اللبناني «شربل داغر» تجربة الكتابة
الشعرية. لكنه يضيف واصفاً عمله بما يشبه ترويض الفارس العربي القديم لفرسه.
ويعترف داغر في المقدمة النثرية لديوانه بأنه يستفيد من رسامين كثر
وتجاربهم في معالجة السطح التصويري. ولتقريب ذلك الأثر يصفهم بأنهم مصورون،
ليكون لاستفادته منهم مبرر مقبول. لكنه في قصيدة من ديوانه الأخير «تلدني
كلماتي» يتساءل: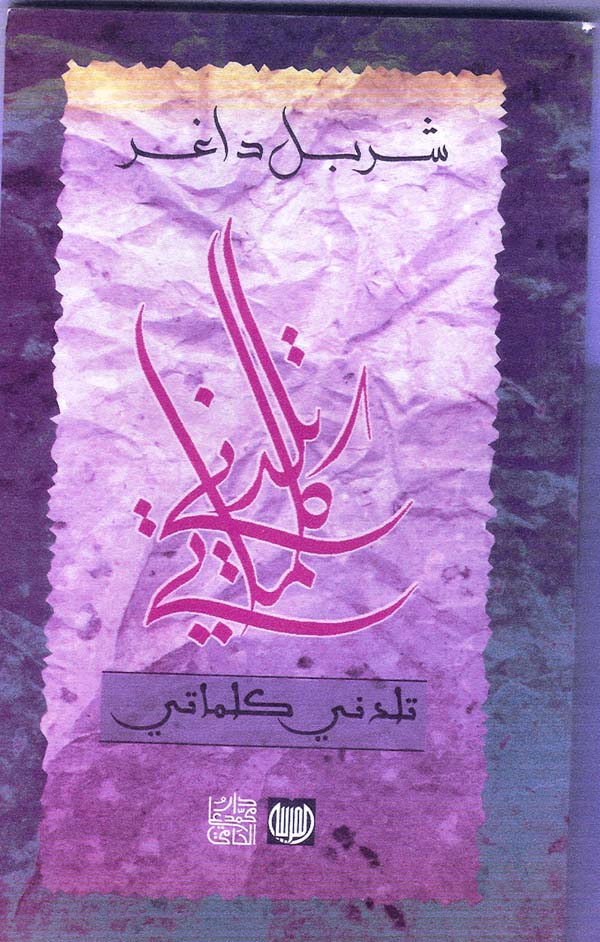
من يكتب من؟
أو هل يكتب عن؟
أللريح أن تضع النقاط على الحروف؟
أم لها أن تكنس أمام بابي؟
... تلدني كلماتي
بما لا يسعه قماطي.
هنا تكون الكتابة أساس تجربة الدين، وكأنه يشهد على تجربته بعد أكثر من ستة
دواوين، ودراسات نقدية في الشعر والفن التشكيلي. وينشئ داغر نصوصاً ذات وجود
ميتا/ نصي؛ بمعنى أنها تراقب الوجود الكتابي كما يعبر عن نفسه لا ليخدم توصيل
معاني سواه. وبذا ينتسب داغر إلى الكتابة عبر انتسابه للكلمات كأمٍّ له ولدته
وحررته من ضيق قماطه أو الطبيعة التي ينشأ عليها البشر ويتحددون بها.
«الكتابة تحفظ لي شيئاً من لهوي القديم»، يقول داغر، مضيفاً: «إنها طريقة
في الهرب، في التملص، في انتهاج سبل سفر متخيلة...». ذلك يكشف غرضية الكتابة
عنده وهدفها، ويعترف بمعوقاتها ومصاعبها، كأن تكون النفس هي موضوع الكتابة فكيف
لي أن أتحدث عنها، وهي تتعين في أكثر من مجال كتابي؟
والخلاصة النظرية التي يخرج بها قارئ المقدمة النثرية هي أن الكتابة، تعبير
عن ولع بالحياة، وخلاص مؤجل، وورطة مستعادة، كما يقول الشاعر.
تعيش بعض القصائد على الحروفية، اقتراضاً من الشاعر لرؤى تشكيلية
واهتمامات حروفية فنية عني بها وانصرف إليها جهده في دراسات منشورة له.
الألف عصا الراحل
والياء مهد الجنين.
كما أنه يقايس كل شيء بالكتابة. هكذا رأى الحصاة التي تأمّلَ وجودها
المتنوع فغدت كما تخيلها.
حصاي
نثر شغفي
في هيكل القصيدة.
سمات كثيرة يمكن رصدها في محصلة داغر الشعرية، منها انصرافه التام إلى
قصيدة النثر كشكل حداثي للتعبير يتوافق مع نزوعه إلى الخروج كما وصفه في
مقدمته، وفي التداخل النصي بين الفنون والقصيدة النثرية. كما يعترف الشاعر في
مقدمته ويذكر الرسام شفيق عبود وطريقته العفوية في تجانس الألوان التي ينثرها
على سطح لوحته لتشكل هيكل عمله. ويذكر النحات رودان وتعامله مع مادة النحت.
وسنرى انعكاسات هذا التأثر في صور شعرية داخل نصوصه، كقوله:
نهر
يواري في الوادي خشيته
من جريانه الهين
بين مخدات النائمين
ويرسم ما يشبه الطبيعة الصامتة:
أقرأ في دفتر الدروب
على ضوء سراج:
جبالاً تنكفئ قبلنا
ظلالاً داخلة في أشجارها
وتسهر بعدنا
غيمة صاحية في مطارحها الباردة.
وثمة مشغّل مهم في القصائد، هو الرؤية السريالية التي تطلق طاقة الخيال لدى
الشاعر حتى يرى أشياء لا ترى إلا بعين الخيال اللامحدود.
صخرة لها غليون
رسائل مختومة دون كلام
دخانٌ أسود
في ليل أزرق
عروس لها ساق من دون موسيقى
وقوام أخضر
ألف بنقطة سوداء فوق سطر شجرة
خضراء مثل برتقالة.
الشاعر لا يعبث، بل يجسد رؤية فيها اختلاطات الخيال ورؤاه الحرة التي لا
يقيدها منطق ما تطلبه القصيدة، ويهيئ لها النثر سعة تستريح فيها وتنجز برنامجها
الذي لا يعبر عما يُرى فحسب بل يبني عالماً بديلاً. خفق أجنحة الدلالات إذ
تفارق ألفاظها يغري العين بما ترى، لا بما فعلت. تلك هي حكمة القصيدة عند شربل
داغر، الذي يفكر بالمكتوب كما يفكر بمغزاه ووجوده.
(شربل داغر: تلدني كلماتي (شعر). دار محمد علي – تونس. دون تاريخ).
شاعر من سلالة الريح
إذا كان شربل داغر ينسب نفسه لكلماته ولادة وقماطاً، فإن موسى حوامدة يصرّح
في عنوان ديوانه الأخير بانتسابه للريح، «سلالتي الريح وعنواني المطر»، ويرضى
بذلك بديلاً من عالم قائم. لكنه، كما يصفه الناقد فخري صالح في غلاف الديوان،
ذو «مقاربة مشاغبة للعالم وأحواله، فهي تخمش وجه السائد وتتحرش به وتتحداه».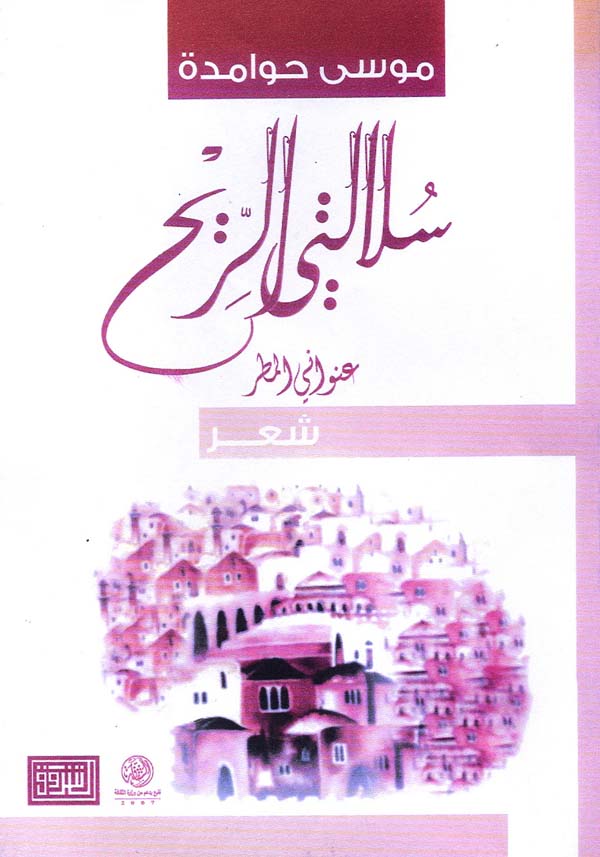
وذلك لا يظهر في ما أثارته قصائده من شغب، كاسم إحداها، ولا بما لاقاه
شخصياً من مساءلات واعتراضات، بل يظهر في صوره وجملته الشعرية وإيقاعات قصائده.
أحمل وجه الشمس في حقيبة الليل
أفتح عروة البهجة
أفتح وأقفل
أقفل
كي لا تدرك الملائكة نشوة الطين.
وفي قصيدة الديوان الرئيسة التي أخذ عنوانها، يسرد الشاعر عن عالم خيالي،
ويعد للقارئ ما يرى أنه نسبه.
قبل أن ترتطم الفكرة بالأرض
قبل أن تفوح رائحة الطين
تجولتُ في سوق الوشايات
أحمل ضياعي، أقتل نفسي
أنا هابيل وقابيل
آدم أنا وحواء
نسل الخطيئة
وزواج السوسن من بيت الطيوب.
وفي هذا التعامل مع التاريخ والعالم تصح ملاحظة علي بدر في مقدمته للديوان
واصفاً موسى حوامدة بأنه «في كل شعره كما في كل حياته يسعى في لعبة الكلمات إلى
اختزال العالم برمته إلى لغته، إلى لغة كلية أو إلى لغة شعرية أو إلى دلالات
إشارية أو إلى نص مرمّز...».
وفي مشاكسة جديدة للعالم ولوجود سبب إضافي قوي، يكتب حوامدة عن صديقه
الشاعر العراقي الراحل عقيل علي قصيدته «يا دم العراقيين».
بُحْ يا دم العراقي بالنشيج
بُحْ بالعويل على خطى أنكيدو
بُحْ بالحرائق والنار
تكلم بتلك اللغة الآشورية المعلقة عند قبر تموز
تمتم بهذيان جلجامش لزهرة الخلود
بحْ يا جسد الشاعر بالهزيمة!!
وفي تجربة طريفة في إطار المشاكسة ذاتها يكتب حوامدة ثلاثاً وعشرين رسالة
قصيرة إلى شعراء وأصدقاء يقول في ختامها:
إلى شاعر سبق ذكره
في خاطري الكثير
لكن القصيدة ليست مقهى مناسباً للثرثرة!
هذا ما يمكن قوله أخيراً حول تجارب قصيدة النثر التي تغري بتلك الثرثرة أو
الاستطرادات التي تحتاج إلى الاقتصاد والتكثيف والتركيز على لغتها وعناصرها
الإيقاعية.
(موسى حوامدة: سلالتي الريح وعنواني المطر (شعر). دار الشروق - عمان،
2007).
|