|
إصدارات
قام
بقراءتها: حاتم الصكر
الوهايبي
في معجم شعري للحيوان
( ) )
كثيراً ما تضعنا الحداثة الشعرية، بما أنها رؤية وموقف من الحياة، إزاء
أسئلة عميقة تتصل بوجود الإنسان ذاته.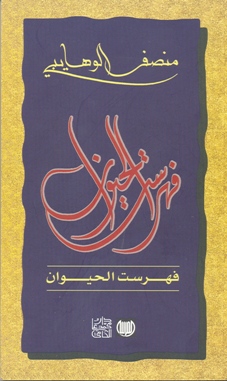
وكثيراً ما يجدُّ شعراء الحداثة ويجتهدون لاجتراح طرق جديدة أسلوبياً
وموضوعياً، وقد تأخذهم محاولاتهم إلى مناطق توحي بأنهم يتراجعون أو يبحثون في
دفاتر الأدب القديمة.
هذا هو شعوري وانطباعي الأول وأنا أقرأ عنوان ديوان الشاعر التونسي منصف
الوهايبي «فهرست الحيوان» (دار محمد علي بتونس 2007). فماذا سيضيف شاعر لمكتبة
الحيوان في الأدب العربي بعد ما احتلت الذاكرة كتب الجاحظ وابن المقفع والمعري
وأجزاء نادرة من «ألف ليلة وليلة» وما تراكم من حكم وأمثولات، وصولاً إلى شعر
الأطفال وقصصهم التي تعتمد أنسنة الحيوان وإدراجه في السرد بطلاً أو شخصية تصنع
الحدث الذي تتسع دلالته لينطبق على البشر وحياتهم؟ بل ستعيدنا ذاكرتنا في باب
المراجع التي يتناص معها ديوان الشاعر إلى بورخيس وحيواناته الخرافية وربما
لحكايات لافونتين وأساطير الشعوب.
لكن المقدمة التي زادت على الخمسين صفحة تعدنا بالكثير. إننا هنا إزاء
تجربة إنسانية طريفة، طرافتها في محاولة الاقتراب من الحيوان الذي تنفر منه في
العادة تربيتنا البيتية والاجتماعية وربما لأسباب تطهّرية دينية، أو لأن المدن
العربية هيأت ساكنيها للعيش في فضاءات مغلقة تفارق تلك السعة واللانهائية التي
أمدتنا بها الصحراء: موطننا الأول الذي تسعى ثقافتنا لهجرانه ومغادرته. بينما
صار الأجنبي صديقاً لحيوانات لا تسع وجودها مدنه الآهلة والمزدحمة والواقفة
أفقياً باتجاه الفضاء.
ها قد أخذنا شعر الوهايبي بعيداً لتأمل المظهر الثقافي لتجربته في صنع معجم
للحيوان، ووضعنا إزاء سؤال أحس أننا سنسأله حين قال: «أي صلة يمكن أن تنعقد بين
الإنسان والحيوان؟ أهي الذكرى؟ ولكن أي ذكرى؟». ويصل به الاستنتاج أو تبرير
فهرسته الحيواني المقترح إلى التساؤل: «ألا يكون الحيوان ذاكرتنا الأولى
المفقودة؟»؛ وبذا يصبح الكتاب الشعري تعقباً لهذه الذاكرة التي تستدق وتصغر
لتخص الشاعر ذاته ولتعم من بعد ذاكرتنا كبشر. وتحكي المقدمة النثرية حكايات عبر
قرين هو «الأخيل» يلتقيه الشاعر لقاء بدويين: فتى وكهل ويعيشان في (تمبكتو)
التي تناظر الاسم القديم لمدينة الشاعر (القيروان). ويستفيد الشاعر من تقنية
المخطوط ليوصل أفكار الأخيل وتداعياته فنكتشف أنه كان شغوفاً منذ طفولته بصور
الحيوانات.
عضاية، حصان، هدهد، حمار، كلب، حلزون، قط، سنجاب، غزال، ضفدع، قرد، خفّاش،
مالك الحزين، أفعى، ذئب... وسواها، هي شخصيات الوهايبي التي تحضر موصوفة من
الخارج أو مستبطنة من الداخل، تنعكس عليها أحاسيس الشاعر ووعيه، بل يتماهى
البشر بالحيوان فتغدو النساء:
نوارس من وحمٍ نسيت أن تطير، والكنعانيون فلسطينيو الزمن القائم محاطين
بأفق من ذئاب يدعوهم لكي يعيشوا أن يكون واحدهم (ذئباً يسعى في إثر ذئاب)،
والعراقيون يقفون فرادى إلى ألواح الطين يتقدمهم تمثال إيكاروس بجناحي طائر،
بينما الهدهد السبئي يموت واهن العينين يخبو في جناحيه الضوء.
فنياً لا يتردد الوهايبي في اصطناع التقنيات الممكنة: أقنعةً كما في حديث
السلحفاة والأفعى، أو سرداً قصصياً عن الكلب، أو تناصاً وتوسيعاً لقصص معروفة
كقصة الحالمين التي نقلها بورخيس عن «ألف ليلة وليلة». كل ذلك في إيقاعات
موزونة تحيط من خلالها اللغة بالتمثيل السردي للأحداث والحكم والأحاسيس التي
بلغت من الرهافة حدّ ألفة الحيوان وصداقته واستكناه محنته (مربوطا إلى ظله)
كأنما ليناظر عبودية البشر ورقّهِم:
ما القرد؟
جنين بشري مثلي أو مثلك،
زوحمنا في رحم الأم معاً
لكنه حاول أن يمشي فيه
فضاق عليه
ومضى يقفز بين الأشجار!
وبقينا نحن قرود الأرض كما كنا
أقداماً في الماء.. رؤوساً في النار!
قليلاً ما تكون... بالشعر والحلم( ) )
الشاعرة اليمنية الشابة ليلى إلهان عبر إصدارها الشعري الجديد «قليلاً ما
أكون» تأتي من الأردن (دار أزمنة) لتقول ما تراه بقصيدة طويلة واحدة تتنقل
مقاطعها القصيرة دون حدود سوى البياض الفاصل بينها أو الصفحات المستقلة التي
تحتلها القصائد.
وقد سمحت هذه التقنية بتأملات وتعليقات تتشبع بالحِكَم وروح الهايكو
القائم على الاقتصاد اللغوي والتهويمات الذهنية التي تفلسف الأشياء وتسبغ عليها
إشراقاً روحياً. لكنّ ذلك لم يمنع ظهور الرومانسية بتجلياتها الشعرية كعلامة
على علاقة الحب وتنويعاته الأنثوية وما يثير من مشاعر وانفعالات وأحاسيس. وهكذا
تتوسع دوائر الملفوظ الشعري، من التأمل والهايكو والرومانسية وأجواء الحب لنصل
من بعد إلى ثيمة أخرى تشغل ليلى إلهان وجيل الكاتبات اليمنيات والعربيات، وهي
الوعي النوعي بوجود المرأة في المجتمع ودورها الثقافي ومكانتها. نحن إذن إزاء
تجربة كتابية بصرية تحتم قراءتها في حالين:
- موحدة كنص طويل يستغرق الديوان كله ويرتبط ببعض دلالياً وبنائياً.
- ومفرّقة في فقرات أو جمل شعرية أو بشكل شذرات ومقاطع موزعة على صفحات
الكتاب.
ولما كانت الشاعرة تكتب قصيدة النثر حصراً فقد تلونت تراكيبها والمستويات
المعجمية والإيقاعية والدلالية لقصائدها بالسرد والاسترسال اللغوي والصوري
والشعوري، فجاءت متطابقة مع التكثيف المقصود في شعرها.
لكنّ في شعرها كما في أغلب شعر المرأة اليوم ميلاً للاستعراض الأنثوي
واستفزاز القارئ بما يمكن أن يكون لعباً على الممنوعات والمحرمات التي لم يعتد
القارئ بأفق قراءته المألوف مطالعتها، وذلك يبدأ من الإهداء الذي يعكس الولاء
الأُسري عبر الأُمّ وحشر الجسد ليعطي دلالات أبعد:
الإهداء
إلى أمي
وروحي المتسعة بالقلق
وجسدي المثقل بركام الخيبة!!!
و...
أما القصيدة الأولى فتبين عبر تشظيها رغبة الشاعرة في التقاط ما هو متناثر
وموزع، ولملمته في القصيدة التي تستغرق الصفحة:
يا الله!
ألهمني
الشعر،
ألهمني
الصبر،
ألهمني
حبك،
واذرفني إلى السعادة!
تلك دعوات الشاعرة على أعتاب القصيدة. لكنها إذ تبلينا بالفعل «أذرفني»
تصنع منظراً لمعمارها الشعري المميز بالبساطة والقرب من النثر الشعري أكثر من
إجراءات وقوانين وإيقاعات ولغة قصيدة النثر.
وإذا كان هذا هو الإصدار الثالث للشاعرة فإن المستوى الذي قدمته قصائدها
فنياً يجعلها في منطقة بوح مترددة بين إيقاعات النثر الشعري القائم على طلاوة
العبارة وجماليات التشبيهات والصفات، فضلاً عن الصدمات التي تعتقد الشاعرة أنها
تجلب اهتمام قرائها كحشرها مفردة الجسد في غير مواضعها:
أصرخ
ويلقي جسدي بنفسه
من بوابة الظل
الظل
الذي لا حياة فيه...
أو تصنع هذه الصورة الكاريكاتيرية للجسد:
جسدي جبن مصري
ووجهي رغيف بارد
وأصابعي حلوى شامية
لهذا من سيأتيني أولاً
لأعطيه
من أشيائي العربية
واللذيذة..؟
الحروفية كالرقش على جسد القصيدة( ) )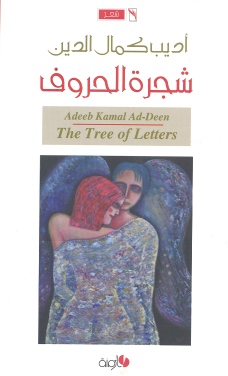
ربما كان تميز الشاعر العراقي أديب كمال الدين بين زملائه من شعراء جيله
السبعيني هو عكوفه على تجربة التزيين الحروفي لقصائده كما في الرسم الذي يستضيف
الحروف وجمالياتها إلى اللوحة لتعميق الإحساس الروحي بها ودون أن تؤدي دورها
الوظيفي في إيصال المعاني، ولخلق الأثر البصري جمالياً وحسب، وهذا ما أراد أديب
كمال الدين أن يصنعه كمقترح لأسلوبية خاصة به، وأوغل في التجربة الحروفية تعضده
موروثات الكتابة الإشراقية الصوفية وتجارب الشعراء والكتاب الصوفيين في تأمل
الحرف، لا في مهمته اللغوية كجزء من كلمة تؤدي وظيفة معنوية أو دلالية، بل بما
توحي من مشاعر وآثارِ تلقٍّ تمس الأحاسيس وتتمثل الأثر فتخلق الإيحاءات في
النفس وتعلي الإدراك الجمالي للعالم الذي يزعم الموسيقيون وعلماء الرياضيات أنه
مكون من عدد ونغم، يتوافقان ويخلقان هذا التوازن الإيقاعي في حركة الكون.
وتحاول الحروف أن تحده بحدودها فتغدو ذات أشكال وهيئات خاصة هي التي يناجيها
ويستلهمها المتقشفون والزهاد والمفكرون في النفس البشرية.
وربما أخذ بعض النقاد على أديب كمال الدين انغماسه في التجربة الحروفية
وانحصاره داخل إطارها المتكرر، وكأنه استراح لها نهائيا (صدرت له عدة دواوين
تحمل عناوينها حروفاً، منها: جيم، نون، النقطة، حاء، ما بعد النقطة، ما بعد
الحرف... والآن في هذا العام: «شجرة الحروف» وهي مجموعة قصائد لا تقف عند
الهوية الحروفية التي أراد الشاعر تكريسها لنفسه كعلامة فارقة لشخصيته الشعرية،
بل تتعداها إلى موضوعات شعرية أخرى كالتأمل في ما آل إليه الوطن وما ملأ أرضه
من دم وما يتعرض له من مآسٍ).
ولكن ما شجرة الحروف هذه التي يتفيأ ظلها الشاعر؟
ليس هناك شجرة بهذا الاسم
أو بهذا المعنى
ولذا أنبتُّ هيكلي العظمي في الصحراء
وألبسته قبعة الحلم
وحذاء طفولتي الأحمر
وعلقت عليه
طيوراً ملونة اتخذت شكل اللون
ثم وضعت عليه
بيضة صفراء كبيرة
اسمها النقطة.
واضح أن الشاعر يقيس العالم بوجوده الحروفي ويسترجع طفولته بهذا المعيار
أيضاً، فتتحد البراءة الأولى للطفولة وكأنها براءة الحرف قبل أن تسلبها
الاستخدامات النفعية في وجوده اليومي، ضمن عملية تشكُّل الكلمات وتأدية المعاني
كما يريدها الإنسان في سياق رغباته ومصالحه.
ولكن في هذه التجربة الحدسية ليس ثمة يقين مؤكد؛ فيغدو الرجوع إلى شجرة
الحروف ذات الوجود الافتراضي –الحلمي- جزءاً من مقاومة شرور العالم وقسوته.
إنها شجرة تخرج من معاناة وجود الشاعر على الأرض ومن دمه المسفوح:
حين تدحرج رأسي على الشاطئ
وسط صهيل الغرباء المنفيين
بزغت من دمي المتناثر على الأرض
شجرة مليئة بالنور والسرور
أتراها شجرة الحروف؟
وإزاء سؤال كهذا يورط القارئ في البحث عن شجرة الحروف. سوف نستنجد بمرجعيات
الحروفية العربية والإسلامية، حيث النون صورة العالم ممتثلاً للكينونة وغارقاً
في الوجود، تحف الواو وسطه المفارق للبدء والمنتهى.
النقطة وحدها لها كيانها المستقل، فهي الأصل في خط الوجود الذي فاض به
العالم عن مبدئه، وصار جمعَ نقاط تستطيع أن تلتقي بها حيث تكون أو تختار اللقاء
على امتداد خط الوجود المتصل بنقطته الأولى:
أنا النقطة
أنا الشمس المكتملة
وأنت البحر اللانهائي
أيها الحرف
أهبط فيك شيئاً فشيئاً
حتى أختفي تماماً.
ألذ ّ من خاصرة غزال
( ) )
يفتتح الشاعر السوري حسين حبش ديوانه «أعلى من الشهوة.. وألذ من خاصرة
غزال» بأبيات من الشاعر الألماني غوته، تمجّد الحب وتلخص ثيمة الديوان (الصادر
هذا العام عن دار ألواح بأسبانيا):
من أين ولدنا؟
من الحب
ما الذي يساعدنا على الغلبة؟
الحب
ما الذي يوحد بيننا دوماً؟
الحب.
ولا ينسى تكرار الإشارة -كما في ديوانيه السابقين- إلى أنه
شاعر يكتب بالكردية والعربية.
هنا يفلح الشاعر الكردي السوري حسين حبش (المقيم في ألمانيا) في أن يجعل
قراءتنا لديوانه الأخير، «أعلى من الشهوة وألذ من خاصرة غزال» متوجهة صوب كونه
ضيفاً على اللغة العربية شأن كثير من الشعراء والكتّاب الذين عرفتهم الثقافة
العربية في مسيرتها الطويلة.
كان يمكن أن تمر قصائده عبر وعي القارئ بها كسواها من الملفوظات العربية،
أي أن يتسلم كلمات نصوصه وتراكيبها وإيقاعاتها ودلالاتها وصورها بلا توجيه
إضافي سوى شعريتها. لكن إصرار الشاعر على وضع ملاحظة كرديته في صدر التعريف به
كما في ديوانيه السابقين،
«غرق في الورد» و«هاربون عبر نهر إفروس» يوجب حساباً مضافاً عند القراءة،
هو استثمار طاقات اللغة الثانية لتعزيز ما يريد توصيله، ويتدخل وعيه الشعري
الأول (أي المتكون بمفردات لغته الأم وسياقاتها وخصوصيتها الثقافية ونتاجها
الأدبي) في تشكيل صياغات قصائده، وهو مبحث مقترح على المهتمين بالأدب المقارن
الذين قد تستوقفهم ظاهرة الكتابة باللغتين والتنافذ الممكن في مهارات الأداء
والصوغ والتعبير والتمثيل الشعري للموضوع خاصة.
تحف بقراءة ديوان حسين حبش ملاحظة أخرى تتعلق بما عرف بشعر المهجرية
الجديدة أو الموجة المهجرية الحديثة التي يمثلها كُتَّاب قصيدة النثر ممن
ينتجون نصوصهم في فضاء المنفى أو المغترب أو المهجر الذي تشكَّل وعيهم الشعري
أو اكتمل في شروطه كما هو مفترض، فيكون مهمة اكتشافها.
سيؤكد انتقاء الشاعر للحب مادة للّقاء بالعربية كوسيلة صوغ وتعبير ذلك
المقتبس الذي أشرنا إليه وهو أبيات غوته وقيمة الحب في الحياة الإنسانية
والعلاقات بين البشر، ويكون (أي الحب) هو الإجابة على التساؤلات الكبرى في
حياتهم.
هل عثر حسين حبش عبر هذا المقتطف من شاعر له احتكاك بالثقافة العربية وأدب
الشرق على مبرر لتسويغ كتابته بلسان عربي شاعري، أعني التذرع بشراكة عاطفة الحب
وتلاوينه الممكنة لتبرير الزيارة وطلب الضيافة؟
قد لا يوجد في الثقافة مطلب تبريري كما في الحدود الجغرافية الفاصلة بين
الدول والقوميات، لكن له حقوقاً إضافية على المستوى اللساني ومظاهره في الشعر
كفن ذاتي ذي خصوصية مضاعفة، أقربها: استيعاب السياقات التعبيرية والدلالية
والإيقاعات المستقرة في اللغة المستضيفة، وانتقال الخبرات والسياقات من اللغة
الأولى إليها. وهذا ما يجب تعقبه والبحث عنه في ديوان عربي مؤلَّف لشاعر كردي،
رغم كل ما يمكن إيراده من مشتركات معروفة وتعايش وانتماء بين الثقافتين.
من الحب ستتمدد قصائد حسين حبش لتنتشر كوجود نصي يعلن عن نفسه داخل هذا
الشعور، بدءاً من عنوان الديوان الذي يستخدم صيغ التفضيل في شطري العنوان: أعلى
من.. وألذ من... لكن العنوان يخفي ادعاءً هو بعض لوازم الحب النرجسية، فالمحب
يرى نفسه متفرداً في أحاسيسه غير مسبوق، كما يلاحظ كثير ممن كتبوا عن الحب
كعاطفة إنسانية، فالوعد الذي يقدمه للقارئ كبير، إنه يعده بما هو «أعلى» من
الشهوة كإحدى ملازمات الحب ومظاهره الجسدية، و»ألذ» جمالياً مما تهبه رؤية أو
ملمس خاصرة غزال. وسنرى أن الشاعر يستعين لتحقيق ذلك بوسائل وتقنيات عديدة
سنشير إليها مادام المقام لا يتسع للتفصيل فيها، وفي مقدمتها الإفادة من السرد
الذي تتيحه قصيدة النثر وتظهر فيه مقدرة الشاعر على خلق أثر الشعر بكلام يبدو
حكياً أو سرداً لواقعة:
نسي ساعته قرب ساعتها
ذاب الزمن
نسي كفه في كفها
انتعشت المسامات
نسي قميصه على قميصها
توردت الخيطان
نسي نسيانه في نسيانها
ذابا في الحب...
تقرب الشاعر من الحب، وعدا التفاصيل الشعورية: اتخاذه البساطة المتعمدة
والألفة المقصودة في التعبير، فلا نعثر على حذلقات أو هيجانات لغوية تتصاغر
التجربة في عواصفها وأصدائها، بل تقوم أغلب كيانات حبش النصية على تقابلات
وتضادات تضع الشاعر أقرب إلى تجربة الشعر الحر بالمصطلح الغربي الذي يشمل شعر
الماغوط وجبرا خاصة أكثر من اقترابه من قصيدة النثر بمفهومها الفني:
أنتِ الشجرة وأنا الفأس.
أنتِ الشمس وأنا القمر
أنت الحديقة وأنا المتسكع
لماذا لا تحاولين المجيء إلي؟
أو كما في نص آخر يقوم على التداعي بالمقابلة:
أنظر إلى الأخشاب
أتذكر الأشجار
أنظر إلى العصافير
أتذكر الطيران
السماء
أتذكر المطر...
كما أن الشاعر يعيد إلى الذاكرة تلك الترانيم العراقية القديمة التي حفظها
لنا الأدب السومري والبابلي وفي قصائد العشق خاصة كما يتضح في «احتفاء»:
العتبة تحتفي بك
وذاك النسر الضجر في الداخل
الباب يحتفي بك
وذلك العاشق الذي ينتظر
قدومك بلهفة شاهقة.
لقد توفرت للشاعر عفوية مقصودة ساهمت في تقريب الحب كعاطفة وموقف وجودي
تترتب عليه أشياء الحياة ومفرداتها بديلاً لغربة يفرضها المكان ولا تفوت اللسان
الإحاطة بها.
الشعر ومفردات الحرب( ) )
تمد الحرب مخيلة الشاعر وذاكرته بمزيد من الرؤى والصور التي يختزنها وتشكل
موقفه الذي يتبلور إنسانياً برفض بشاعتها وما تخلفه في النفوس والأرواح. وهو
موقف شعري لم يتوقف تكراره وإعادة صياغته منذ كتب زهير: «وما الحرب إلا ما
علمتم وذقتم...».
ولكن الإنسان الذي سُمي بذلك لنسيه (بتأويل أبي تمام) لا ينفك يعود إليها
(أي الحرب) ليجر على نفسه وكوكبه المزيد من الآلام والويلات.
ولكن الحرب تلون القاموس الشعري كذلك بتلاوينها واشتقاقاتها ومجازاتها
وصورها، وببلاغتها إذا شئنا التوسع قليلاً.
ها هو ذا شاعر عُماني شاب (زاهر السالمي،1972) يصدر ديواناً لعله الأول-
كما يشير الإصدار (دار شرقيات 2007) يعنونه بعنوان حربي بجدارة «عُبوَّة ناسفة»
جعلت القارئ قبل قراءة التعريف به يظنه عراقياً أو فلسطينياً في أبعد الفرضيات؛
لأن العنوان الصادم المستعار من أدبيات الحرب ويومياتها القاتلة في أرض كبلاد
الرافدين وعاصمتها (التي سمّاها العباسيون- يا للمفارقة- دار السلام) يأتي من
شاعر يسكن بعيداً عن رعب الحرب والعنف والاحتلال، لكنه كشاعر استجاب لمعاناة
الإنسان، وتخيل ما شاءت مخيلته، بل توسّع في مجازات الحرب ودلالاتها ليغدو كل
شيء خارجاً من رحمها، ها قد صار رأس الشاعر «عبوة ناسفة، يحمله باتزان خوف أن
ينفجر، وجيبه ملغم.. بالعصافير، والمرأة كالرمح...».
وما دامت الحرب هي المرجع التخييلي واللغوي والصوري، فهي تقيم في الدلالة
أيضاً وتتمدد في المعاني. الحب صراع شبيه بحرب بين الشاعر وحبيبته:
الدمعة..
سلاحها الفتّاك
الحب دفاعي الأوحد
برج الثور موعدنا
تحمل الأرض على قرن
أحمل السماء على قرن
نفترق،
ولا نلتقي..
إلا في فصل الإخصاب.
وفي قصيدة «أفعل ما أشاء» تحضر الحرب في المفتتح بسلاح بدائي أيضا
(الخنجر): اختراع العقل الأول قبل التحضر):
أشحذ خنجراً على نحري
فقط للتأكد من جاهزيته.
إن معاينة القاموس الحربي في قصائد الشاعر تشير إلى مسألة ثقافية تعني
القراءة المنهجية التي لا تكتفي بتعقب التشكلات اللغوية والصورية والإيقاعية
للنصوص، بل تتعقب وتشتق دلالاتها الثقافية وتحولات الخطاب الشعري وتأثراته
بالمحيط واقتراضه من إجراءاته وآلياته، وهذا ما استوقفنا في قصائد السالمي، وهي
كلها قصائد نثر تحاكي في قِصَرها ما عُرف بقصائد الجملة الشعرية أو الومضة
والشذرات السريعة التي تستدق وتقصر فتصل إحداها إلى ثلاث كلمات فقط لتخلق
مفارقة دالة مع العنوان المكون من أربع كلمات:
لن يستطيع إزعاجي أحد...(العنوان)
كصلاةٍ
لا
تَصِل.
وتكون الحرب ذات حضور دلالي ولغوي في قصيدة تعكس الموقف من الآخر والصلة به
الآخر الذي يشاركنا المكان والزمان وله ظله وثقله وأعرافه. وهي قصيدة «حياة»
التي تؤثثها مفردات الحرب وجزئياتها:
بعدما أفرغتُ فيهم حشداً
من رصاصات الرحمة
كومتُ أجسادهم أكياس رمل
تقيني الطلقات
أفرغتُ جماجمهم، صنعتُ منها خوذة
اقتلعتُ عيونهم، ركبتُ منها منظاراً
أراقبُ به حركة الجبهة
ومن آذانهم نصبتُ شبكة رادار...
هكذا تسرد القصيدة معركة الشاعر مع الآخرين حيث انتصر عليهم واقتعد جثة
أحدهم ليستريح، لكنه اكتشف أنهم هزموه بألسنتهم التي نسي «انتزاعها واستعمالها
مسحوق بارود».
ديوان الشاعر العماني الشاب وقاموس قصائده المنتزع من سياق الحرب ويومياتها
وإيقاعاتها الضاجة المحتدمة، تلفت إلى تلك التبدلات والتحولات التي أشرنا إليها
على مستوى الخطاب الشعري نفسه لا القصائد كبنى نصية فحسب. |