|
سؤال العدد
ما الجدوى التي تحققها معارض الكتاب اليوم؟
( ) )
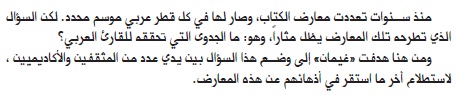
* هل
كل
كتاب
هو
خير
جليس؟
د. أحمد ياسين السليماني
 الكتاب
حيزٌ مكاني
للمعرفة.
يتسع
هذا الحيز
باتساع الرقعة المعرفية،
يتمدد، يستطيل،
يضيق، ينكمش،
وفقاً لثنائية
المحتوى والشكل،
والكتابة والتلقي؛
إذ تقوم
المعادلة على وصف
الكتابة بأنها
تلك التي
تحمل المحتوى، وتحدد
مساحاته في
الكتاب، ومساحات التلقي
فيه، وبؤر
توتراته. وكلما
اتسعت توترات
الكتابة وما
تحدثه من
انزياحات في الوعي،
اتسعت مجالات
التلقي، وتنوعت
تحولاته الديناميكية.
ولا
يغيب الشكل،
على هذا
النحو، عن فاعلية
الكتابة، وما
تفرزه من
توترات، وما تنتج
من مساحات
فجوات وخلخلات فيه.
وما
الكتاب إلا
وعاء حامل لمجموع
هذه العناصر.
تتواشج
هذه العناصر
مع فعل
القراءة، ومتولداتها التي
تحيل إلى
أبنية معرفية ناتجة
عن اشتباك
القراءة مع الكتابة.
تختلف
هذه الأبنية
في محتوياتها
التكوينية من
كتاب إلى
آخر، ومن قراءة
إلى أخرى. الكتاب
حيزٌ مكاني
للمعرفة.
يتسع
هذا الحيز
باتساع الرقعة المعرفية،
يتمدد، يستطيل،
يضيق، ينكمش،
وفقاً لثنائية
المحتوى والشكل،
والكتابة والتلقي؛
إذ تقوم
المعادلة على وصف
الكتابة بأنها
تلك التي
تحمل المحتوى، وتحدد
مساحاته في
الكتاب، ومساحات التلقي
فيه، وبؤر
توتراته. وكلما
اتسعت توترات
الكتابة وما
تحدثه من
انزياحات في الوعي،
اتسعت مجالات
التلقي، وتنوعت
تحولاته الديناميكية.
ولا
يغيب الشكل،
على هذا
النحو، عن فاعلية
الكتابة، وما
تفرزه من
توترات، وما تنتج
من مساحات
فجوات وخلخلات فيه.
وما
الكتاب إلا
وعاء حامل لمجموع
هذه العناصر.
تتواشج
هذه العناصر
مع فعل
القراءة، ومتولداتها التي
تحيل إلى
أبنية معرفية ناتجة
عن اشتباك
القراءة مع الكتابة.
تختلف
هذه الأبنية
في محتوياتها
التكوينية من
كتاب إلى
آخر، ومن قراءة
إلى أخرى.
إن
فعل الكتابة
وفعل القراءة
عنصران يرتبطان
-بلا
شك- بزمن
الكتابة وقراءتها،
وهو الزمن
الذي يستغرقه المداد
أو الحبر،
وما يستغرقه المتخيل
من أدوات
تحيل إلى تراكيب
واعية للحروف
والكلمات والجمل
اللغوية؛ وزمن
آخر هو زمن
القيام بالقراءة.
ويفضي
التراكم العددي
الهائل لعديد
الكتب، في
ضوء ذلك، وهو
هذا التراكم
الذي يحدد
المعرض مساحاته، يفضي
إلى بناء
معرفي ضخم يستطيل
في أروقة
من مساحات هذا
المعرض، يتراوح
في محتوياته
ما بين
الرديء والجيد، والغث
والسمين، والمحصلة
النهائية ستكون
قائمة في
تلك التحديدات التي
سترسم ملامح
المغايرة لفعل
الاقتناء والأضواء،
ستحدد مساراته
توجهات القراءة،
ورغبات الاختيار
والتلقي، لعناوين
الكتب، والضمانة
الوحيدة لحسن
الاختيار تحددها
التوجهات الفكرية
والثقافية والأدبية
والعلمية.
والسؤال
اللافت والملح،
هو:
هل
كل كتاب هو
خير جليس
للمرء؟ حينما قال
الشاعر المتنبي
هذا الشعر
البيتي، نهضت كلماته
متكئة على
زمن يغاير كل
المغايرة هذا
الزمن الذي
نعيش فيه، فزمنه
"يسهر الخلق
جراها ويختصم"
أما الآن
فلا يسهر الناس
على كتاب
ولا يختصون.
لقد
كان زمن
المتنبي زمن الفعاليات
المنتجة للمعرفة،
زمن الكتابة
التي تجاوزت
هذا الزمن
من حيث الفعاليات
المنتجة في
الكتابة والقراءة معاً،
زمن المستويات
الراقية من
الثقافية والمعرفة، زمن
الشغف القرائي
والتطلع إلى
مزيد من
المعرفة؛ على خلاف
هذا الزمن
الذي يعتريه الالتباس
واللغط ويحيا
في حما
الارتباك والقلق، وفي
عالم من
المشكلات المزمنة التي
لا طائل
لها. زمن
الفضائيات والانترنت
بعيداً عن
ارتياد عوالم الثقافة
والمعرفة الحقيقية،
زمن اقترب
فيه مستخدمو هذه
الوسائل الاتصالية (من
الشباب) نحو
تفاهات التلقي
وانحطاطاتها في
غالب الأحيان،
وتحيدوا عن
طموحات الهوية ومكونات
تشكيلها.
هذا
الزمن الذي
قلّ!تْ
فيه مدخرات
العيش، وارتفعت فيه
أسعار الكتب،
قّلتْ نية
القيم وازدادت فيه
المنحطات، هو
زمن يجعل
شراء الكتاب صعباً،
وقراءته كحاطب
ليل.
إذاً
لم يعد
الكتاب خيرَ جليس
لفئة واسعة
من جبل الشباب،
إنه خير
جليس لنخبة من
الناس تقبض
على الكتاب كمثل
من يقبض
على جمر، هو
الذين ألفوا
مسامرته، والاستئناس
به، واقتناص
أروع اللحظات
الأليفة والممتعة
معه.
إذاً
ما الذي
يدفع الشبان إلى
التملص من
القراءة الجادة، والنزوع
إلى حالة
من اللاقراءة؟ هل
هو الفراغ
القاتل، أم سعر
الكتاب الذي
بالغ في
ارتفاعه، أم حالة
الإحباط، أم
الكسل أم
غير ذلك؟
وينبري
سؤال آخر
في هذا المجال:
هل
سيلغي الحاسوب
الإلكتروني.
ونظام الانترنت
الكتاب؟ أزعم
أنه لن
يستطيع فعل ذلك،
ولا يحق له
ذلك، إن
حضور الكتاب أزلي،
وسيبقى كذلك،
وإنه ضرورة
ثقافية، وأهم ضروراتها
وديمومتها. إن
تسليط العين
على الكتاب
وعنوانه، شعور يتملك
المرء لا
يماثله أي شعور،
وتشكيل لمجموعة
أحاسيس متدفقة،
تحتشد في
وعي المرء؛ لانهائية
البعد. سيبقى
الكتاب حاضراً
ما وجد
الإنسان وما حضر،
بوصفه آية
من آيات تكوينه
العقلي والذهني،
طريقه الكامل
إلى الانترنت،
لأسباب عدة،
منها ما
يتعلق بالتقنية
التكنولوجية، ومنها ما
يتعلق بالوعي
بهذه التقنية،
ومنه هذه
الأسباب عدم القدرة
على فعل
ذلك في ظل
قصور الإمكانيات
اللازمة، لذلك
لا يمكن
للمرء أن يستغني
عن الكتاب،
مع فارق القراءة
والتلقي بيننا
نحن العرب
جميعاً ودولة صغيرة
أوروبية مثل
اليونان التي
تفوق إصداراتها
إصداراتنا جميعاً.
إن
وضع اليد
على الكتاب يعد
ممارسة فاعلة
ونشطة لخلايا
الوعي الذي
يشرئب لملاقاة حروفه
ومفرداته، وفعلاً
من أفعال
المباشرة والحضور، حضور
وجودي مرئي،
باقٍ لا
يندثر.
أما
حضوره في
الانترنت فيعد حضوراً
آنياً، يغادرنا
بلحظة غير
متوقعة، لقصور التقنية
ولخبطة الاستعمال.
إذاً
فالقراءة عبر
الوسائط الاتصالية
الجديدة، تعد
قراءة
يتيمة
لا أب لها،
ولا أمّ.
أما
الكتاب فينتسب
إلى نسل
عظيم وبعيد، توارثه
كابراً عن
كابر. وحتى
تفي تقنيات
الانترنت بإدخال كل
الكتب إليها،
سيكون الخوف
من اختفائها
بلحظة شرسة
وقاتلة أمراً وأرداً
في أي زمن
أو مكان.
وعناوين
الكتب ذاتها
بعنصر الإحساس،
ثقافة عامة،
لا يستغني
عنها المرء.
أما
محتوياتها المعرفية
فيمكن أن
نعيش حالة من
المراوحة القيمية
بين كتب
وأخرى، ولكنها في
الأخير تشكيل
متكامل في
مجموعها لثقافة الصواب
والخطأ، لثقافة
الممكن وغير
الممكن، لثقافة
القيم واللاقيم،
لثقافة القراءة
واللاقراءة، ولثقافة
المعرفة واللامعرفة...
إنها
ثقافة كامنة
في الأحرف
والكلمات والجمل المرصوصة
والمخطوطة في
الكتاب لثنائيات
ضدية، ولكنها
في الأخير
تشكيل كرؤية تفسر
معنى الثقافة
وحروفها بكل
كينونتها.
* ملاحظات
عابرة
في
قضية
غير
عابرة
قادري أحمد حيدر
 إن معرض
الكتاب هو في
الأصل فكرة
مدنية، قضية ومعنى
مرتبطان بحضور
المدينة واتساع
فضاءاتها (طرق،
أنوار، أنظمة
عقلانية حديثة،
تعليم، مؤسسات...).
وبالنتيجة،
هو تمدد
لمجالات نشاط المدن،
وتكريس لفعلها
الثقافي التنويري.
إن
تكريس تخصيص
أيام أو
أسبوع أو أكثر
لعرض الكتاب،
والاتفاق على
اختيار مكان
عام له
يرتاده أصحاب الطلب
المختلفون المتعددون
المتنوعون، إنما
هو يوم
لسيادة المعرفة والعقل
والفكر والإبداع؛
فالكتاب والإعلان
عنه وتسهيل
تقديمه للقارئ/
المتلقي
في يوم
عرسه هو بمثابة
حج نحو
كعبة الحرف وفضاء
الكلمة. إن معرض
الكتاب هو في
الأصل فكرة
مدنية، قضية ومعنى
مرتبطان بحضور
المدينة واتساع
فضاءاتها (طرق،
أنوار، أنظمة
عقلانية حديثة،
تعليم، مؤسسات...).
وبالنتيجة،
هو تمدد
لمجالات نشاط المدن،
وتكريس لفعلها
الثقافي التنويري.
إن
تكريس تخصيص
أيام أو
أسبوع أو أكثر
لعرض الكتاب،
والاتفاق على
اختيار مكان
عام له
يرتاده أصحاب الطلب
المختلفون المتعددون
المتنوعون، إنما
هو يوم
لسيادة المعرفة والعقل
والفكر والإبداع؛
فالكتاب والإعلان
عنه وتسهيل
تقديمه للقارئ/
المتلقي
في يوم
عرسه هو بمثابة
حج نحو
كعبة الحرف وفضاء
الكلمة.
إن معرض الكتاب
هو بالنسبة
للمشتغلين بالقراءة
والكتابة، والمسكونين
بالهمِّ الثقافي والإبداعي
بمثابة تجديد
وتعميق لعقد
صداقة لا
تنتهي مع الكلمة
المقدسة والنبيلة،
أيام نذهب
فيها إلى المحراب
المقدس للكتاب،
نفتش بين
دفتيه، أوراقه، وصفحاته،
عمَّا ينقصنا
من أحلام،
وما نحتاجه من
رؤى، هي
أيام أعياد متواصلة،
أيام يحتفي
فيها الكتاب والمبدعون
بأنفسهم، وبأصدقائهم،
وبالآخر الثقافي
الإنساني، الذي
يشاركونه همَّ
الكتاب والإبداع. هي
أيام أعياد
متواصلة مشحونة بفرح
اللقاء بالأصدقاء
والأحبة، القريبين
منا والبعيدين
عنا، الذين
نعرفهم مباشرة والذين
لا نعرفهم
بالاسم، أو الجسد،
ولكننا متواصلون
ومتوحدون بهم
أكثر من
كثيرين ممن يعيشون
بيننا وعلى
مسافة قريبة من
غرف نومنا،
ولكننا لا نراهم،
ولا نعرفهم.
إن
معرض الكتاب
هو لحظة
فرح وحب وصفاء،
نتجهز لها
بكل ما نملك
من استعداد
عقلي، وبقدر ما
بأيدينا من
مال زهيد يساعدنا
على شراء
بعض ما نحتاجه
من الكتاب.
هي
لحظة فرح
ينتظرها أصحاب الشجن
الفكري والثقافي
والإبداعي، مثلما
ينتظر الأطفال
أيام أعيادهم
الخاصة بهم.
معرض
الكتاب يفترض
أن يكون
عيداً للمفكرين والمثقفين
والمبدعين عموماً...
يمكن
القول اليوم
إن فرحتنا
بأيام أعياد معرض
الكتاب بدأت
تتلاشى وتنكمش
لتصير في
منتهى الصغر، وفي
أدنى درجات
سلم الفرح، بل
لم يتبق من
الفرحة بالكتاب
سوى رؤيتنا
له من بعيد،
ومشاهدتنا عناوينه
مع وقف
التنفيذ، كمشاهدة الفقراء
محتويات فترينات
سوبر ماركت،
من الطعام
والخضار والفواكه والملابس...
دون
القدرة على
مطارحتها الأكل في
مائدة الطعام
أو اللبس.
لقد
أوصلتنا العولمة
الرأسمالية الوحشية،
في طبعتها
الاستعمارية الجديدة (نيوليبرالية)،
وفي تموضعاتها
السياسية والعسكرية
والاقتصادية والفكرية
والثقافية، إلى
حد الجوع
لكل شيء، بعد
أن أصبحت
العولمة تعني في
الواقع عولمة
للجوع، والفقر،
وأصبح توزيعهما (الجوع
والفقر)
عادلاً وبالقسطاس
على الجميع،
صارت معه
العولمة الوحشية الرأسمالية
عبارة عن
"اوستراد" كبير، أو
قرية عالمية
كونية للأغنياء
فقط، غدت
معه المعلومة والمعرفة
محتكرتين، وبضوابط
قانونية دولية،
تحت مسمى
"حق الملكية الفكرية"،
بما فيها
معلومة الأدوية، المتصلة
بحياة الناس
ووجودهم، والتي
غدت من
أكثر السلع احتكاراً
وقوة، وقهراً
ولعباً بمصائر
البشر وبمعنى
وجودهم كله
في الأرض.
صحيح أن
المعرفة غدت سلعة
ومعلومة، ولكنها
سلعة ومعرفة
محتكرتان وليستا
مشاعتين، إلا
بما يجيزه
ويتيحه الإعلام، عبر
المجمعات الصناعية
العالمية (العسكرية،
والنفطية، والمالية)
من
ترهات حول
معارف ومعلومات تافهة
وليس لها
أية صلة بالتقدم
المعرفي والعلمي
والتقني؛ ذلك
أن المعرفة -كقوة
وسلعة جبارة
في التقدم
العلمي المعاصر-
هي
في طريقها
لاستكمال صورة احتكارها
بيد من
يملك ويحكم العالم
اليوم، والذي
ما يزال
حتى اللحظة رافضاً
وممانعاً لوجود
وقيام عالم
متعدد الأقطاب، مبقياً
العالم كله
عند لحظة سقوط
العالم القديم
ثنائي القطبية،
وهيمنة القطب
الواحد في
طابعه العسكري، وليس
الاقتصادي.
ومن هنا
مأساة علاقتنا بمعارض
الكتاب وغيرها
مما له صلة
بحاجاتنا الإنسانية
العامة.
إن مأساة علاقة
الكتاب والمثقفين
والمبدعين، من
أبناء الطبقة
الوسطى، التي
في طريقها
إلى الاندثار، وغيرها
من شرائح
المجتمع الفقيرة، بمعارض
الكتاب، هي
الأعمق والأخطر؛ ذلك
أن معارض
الكتاب إنما أقيمت
من أجلهم،
وكانوا تاريخياً الداعين
لها، ولقيامها
ووجودها، وهم
اليوم أكثر
الفئات والشرائح اغتراباً
عنها، بعد
أن تحولت إلى
سلعة، تقهرهم
وتصادر معنى
وجودهم، وخارجة
عن إراداتهم،
ومستقلة عنهم. صحيح
أنهم ينتجونها
بالفعل؛ ولكنهم
لا يستطيعون
امتلاكها، أو
حتى شراءها؛
وهو قمة
الاغتراب والاستلاب؛ اغتراب
المثقف والمبدع
الكاتب عن
ذاته الثقافية وعن
هويته وعما
ينتجه ويقدمه، بعد
أن تحولت
إلى سلعة، ومادة،
وشيء موضوع
في سوق العرض
والطلب. إنها
مأساة سلطة
رأس المال والبضاعة
الرأسمالية في
صورة العولمة
الرأسمالية الجديدة/
القديمة،
وهي ذاتها
الفكرة الفلسفية الاقتصادية
التي أشار
إليها ماركس في
كتابه "مخطوطات"،
(1844) الفلسفي
الاقتصادي الذي
عالج فيه
مشكلة العلاقة بين
الإنسان (العامل)
وبين
السلعة التي
ينتجها، وكيف
تتحول إلى
قوة وسلطة مفصولة
عنه، ومستقلة
عن إرادته،
وتتحكم بمصيره الذاتي
الإنساني؛ يتحول
ما ينتجه
إلى قوة تستلبه،
ويكون مغترباً
عنها، وهي
نفسها علاقة الكاتب
والمبدع اليوم
بالكتاب، وبمعارض
الكتاب؛ إذ
أصبح طموح الكاتب
والمبدع المنتج
للفكرة الثقافية،
أن يتمكن
من امتلاك ناتج
عمله الإبداعي،
ولا يتحول
إلى شيء مفصول
عنه، وقوة
تستلبه، لا يستطيع
إهداءها لمن
يحب أو
يريد بسهولة ويسر،
حتى أن بعض
الكُتَّاب في
معارض الكتاب
ليس بمقدورهم
إهداء بعض
كتبهم لمن يحبون،
كما ليس
باستطاعتهم ذلك مادياً،
وهنا تتجسد
قمة حالة الاغتراب.
ولا تتوقف مأساتنا
اليوم بمعارض
الكتاب عند
هذا الحد، بل
إننا نشهد
اليوم تراجع القيمة
المعرفية والثقافية
والإبداعية، الإنسانية،
في محتويات
معارض الكتاب العربية
قاطبة، والاختلاف
فيما بينها
فقط في الدرجة،
وليس في
المستوى والنوعية، حيث
الملفت في
محتويات معارض الكتاب،
في اليمن
على وجه الخصوص،
وخاصة خلال
العشر السنوات الأخيرة،
هو غلبة
الكتب ذات الطابع
التراثي والتاريخي،
أو ذات
التوجه الديني السلفي،
المتماهية مع
ثقافة الغلو
والعنف والتطرف،
ثقافة إقصاء
الآخر، ومحاولة
ادعاء امتلاك
الحقيقة. وهي
في غالبيتها
كتب نمطية
مكررة، على كثر
عناوينها.
والملاحظ أنها
كتب متخمة
بثقافة الكراهية وعدم
التسامح، وإقصاء
الآخر... كتب
مطبوعة بأوراق
مصقولة جيدة،
ومع ذلك
رخيصة، لأنها مدعومة
من جهات
التسويق الإيديولوجي.
معارض
كتاب تحس
فيها أن صلتك
بالآخر (العالم)،
تتقلص وتمحَّي،
لصالح ثقافة
العزلة والتشرنق
حول الذات
الواهمة والمريضة، خاصة
وأن معارض
الكتاب ومحتوياتها صارت
مقيدة ومشروطة
بجملة من
المحرمات والضوابط
والتابوهات (السياسية،
والدينية، والجنسية،
والطبقية، والأخلاقية)،
وجميعها تابوهات
يحكمها مزاج
أيديولوجي أحادي
يدعي امتلاك
الحقيقة واحتكارها،
وليس عقلاً
إبداعياً إنسانياً مفتوحاً
على جميع
جهات الروح.
لقد وصل الأمر
ببعض رجال الدين،
ولا أقول
"علماء الدين"، في
بعض دول
الجوار (السعودية
تحديداً) إلى
إصدار فتاوى
تكفيرية وتحريمية
وتجريمية، ضد
بعض الكتب،
وبأسماء ثقافية إبداعية
معينة. بل
إننا نسمع
اليوم فتاوى بتكفير
بعض دور
النشر، والناشرين فيها،
وفتاوى بعدم
جواز إدارة
النساء والفتيات للأجنحة
في معارض
الكتاب، بل وحتى
بعدم ارتيادهن
معارض الكتاب،
إلا في
أيام محددة مخصصة
لهن، حتى
لا يحتككن بالرجال(!).
ويطالب
البعض بعدم
إيكال النداء الصوتي
بالميكرفون في
المعرض للفتيات؛
بسبب أصواتهن
الرخيمة التي
تتردد في
جنبات المعرض، لما
تثيره من
هواجس خبيثة في
الرجال(!).
ويعتبر بعض
رجال الدين
السعوديين، المتشددين، دخول
دواوين عبد
الوهاب البياتي، ومحمود
درويش، ومعين
بسيسو، وحتى
السياب، وكتب
المفكر الإسلامي
نصر حامد
أبو زيد، وحسن
حنفي... ضمن
المحظورات والمحرمات؛
بسبب طابعها
"المعادي" للدين
الإسلامي، وأن
فيها كفراً،
وسباباً، وجنساً...
ويوردون
مقاطع أو
فقرات أو نماذج
من قصائد
لهؤلاء الشعراء، مفصولة
عن سياقها
الإبداعي الشعري، ومجتزأة
عن سياقها
الموضوعي الفكري.
ومما
أوردوه دليلاً
على ذلك من
قصائد محمود
درويش المقطع
التالي:
"لكم ربكم
ولنا ربنا،
ولكم
دينكم ولنا
ديننا،
لا تدفنوا
الله في
كتبٍ
وعدتكم بأرض
على
أرضنا
كما تدعون،
ولا تجعلوا
ربكم
حاجباً في
بلاط
الملك!
فخذوا وقتكم
لكي
تقتلوا الله!".
* * *
إضافة إلى كل
ذلك فإن
معارض الكتاب في
بلادنا، ومنذ
عدة سنوات،
فقدت بريقها الذي
كان، حين
كانت تشبه خلية
النحل، ذهاباً
وإياباً، في
البحث عما
نريد، وما ينقضنا،
ما يجعل
المعرض يتحول إلى
مشهد ثقافي
إبداعي متحرك يحتوي
على فعاليات
ثقافية وفكرية
وسياسية وأدبية
ونقدية وفنية
متنوعة، محاضرات
هنا، ندوات
هناك، عرض نقدي
لكتاب أو
كتب أثارت جدلاً
عربياً وعالمياً،
توقيع كتاب
أو ديوان شعر
أو رواية،
عروض فنية تشكيلية
في مكان
آخر، صوت الأغاني
الرائعة والموسيقى
الراقية تملأ
فضاء المكان،
ضيوف من
رموز الثقافة والأدب
والنقد والإبداع
العرب، مدعوين
للمساهمة الثقافية
والإبداعية على
هامش فعاليات
المعرض... يغدو
معرض الكتاب
عبارة عن
ورش عمل ثقافية
إبداعية متحركة.
إن
كل ذلك
البريق والتألق في
سمو الروح
والعقل فقده العديد
من معارض
الكتاب، في أكثر
من مكان
عربي، وليس في
اليمن وحدها.
إن
ثقل الوطأة
عندنا أكثر قتامة
وبشاعة، خاصة
مع واقع
ضيق حال الناس
الاقتصادية والمعيشية،
واتساع حدة
الفقر ورقعته، التي
طالت بالضرورة
القطاع الواسع
من الكتاب
والمثقفين والمبدعين، بعد
أن جرى
تفكيك وتدمير الطبقة
الوسطى، فلم
يزد معها
معرض الكتاب عن
كونه عملية
تجارية حسابية (بيع
وشراء)،
فاقداً للروح
والمعنى. وهذا
في تقديري
جزء من حالة
ثقافية سلبية
عامة طاغية
على كل المشهد
الثقافي والفني
والإبداعي، وليست
مقتصرة على
معارض الكتاب.
ملاحظات
عامة:
-
هناك
قسم كبير
من زوار
المعرض/
المعارض، يأتون
فقط للزيارة
ولإشباع رغبة
روحية ثقافية
في رؤية
المعرض، بعد
أن أصبحوا
غير قادرين
على الشراء.
وهؤلاء
هم أكثر
الناس قهراً
واستلاباً، لعدم
قدرتهم على
اقتناء وشراء
ما يشعرون
أنهم بحاجة
إليه من
الكتب، والذين
هم في
أمَسِّ الحاجة إليها
بالفعل لإشباع
حاجاتهم الروحية
والثقافية الإبداعية
الإنسانية.
والاكتفاء
بزيارة المعرض
هو بمثابة
تعويض سيكليولوجي
عن عدم
القدرة على الشراء،
وتأكيد للذات
أمام الناس،
وأمام الآخرين
من رواد
المعرض.
-
هناك
كتب ليست
بالمستوى الفكري
أو الثقافي
والإبداعي الذي
يستحق، حظيت
بمبيعات كبيرة،
حسب ما
تقول دور النشر،
ووفق ظاهر
الإقبال عليها؛
وذلك عائد
إما إلى
أن تسويقها
إعلامياً على
المستوى العربي
كان جيداً
جداً، وإما
إلى أنها
أثارت قضايا
إشكالية محرمة
إعلامياً (سياسية،
أو دينية،
أو جنسية)،
وإما بسبب
ارتباط هذه
الكتب بحوادث
معينة، سياسية
أو أمنية،
أدت إلى
منعها ومصادرتها
مما زاد
من حجم
الإقبال عليها، وإما
لأن اسم
مؤلف الكتاب
بارز ومشهور
ذائع الصيت،
وليس لقيمة
ذاتية معرفية
إبداعية في
الكتاب ذاته.
-
قسم
آخر يأتون
إلى المعرض
ويشترون ما
عنَّ لهم
من الكتب
المختلفة، الدينية
والتاريخية والفلسفية
والاقتصادية والعلمية
والتجارية والأدبية،
حتى آخر
المطبوعات الفضائحية؛
وذلك ليحتفظوا
بها ديكوراً
في مكتبات
منازلهم، كجزء
من أثاث
المنزل، وديوان
المقيل تحديداً،
مع أنهم
في أعماقهم
لا صلة
لهم بمحتويات هذه
الكتب، إن
لم يكونوا
في أعماقهم
لا يحبونها،
إن لم
أقل يحتقرونها
ويعتبرونها مضيعة للوقت
ولا تصلح
حتى للتسلية
في أوقات
الفراغ، ولكن
لا مانع
من الاحتفاظ
بها كديكور
في صالون
المقيل، مثل
أي قطعة
أو تحفة،
لا وظيفة
لها سوى
تزيين صورة
المنزل وشكله
الخارجي.
-
هناك
قسم آخر
من زوار
المعرض يأتون
مع عائلاتهم
للزيارة وتزجية
وقت الفراغ،
والتعرف إلى
المكان.
كما أن
هناك من
يأتون للزيارة
مع أسرهم
لشراء بعض
كتب الطبخ
أو الصحة
العامة أو
السباحة أو
تربية الأطفال،
وهي اليوم
تحتل مساحة
لا بأس
به في معظم
معارض الكتاب
العربية.
-
كما
أن من
مرتادي معارض الكتاب
طلاب العلم
في المدارس
والجامعات، الباحثين
عما يخصهم
مباشرة في
تخصصاتهم العلمية
والدراسية.
*
معرض
الكتاب
... وآمال
مرجوة
محمد
عبد الوكيل جازم
 لم
أعرف
لذة
تشبه
لذة
القراءة،
التي
يكون
الكتاب
دائماً
وسيلتها.
ولم
أستمع
إلى
نداء
يشغلني
عن
العالم
كما
يفعل
الكتاب.
وعادةً
ما
يحدث
لي
مع
الكتاب
مسٌّ
يشبه
هيام
العشاق.
ففي
معرض
الكتاب
الذي
دارت
تفاصيل
مسرحيته
قبل
أيام
لم
أكن
مدعواً
إلى
المعرض،
ومع
ذلك
فقد
ذهبت،
وفاءً
مني
لهذا
العشق
والمرض
الأبدي. لم
أعرف
لذة
تشبه
لذة
القراءة،
التي
يكون
الكتاب
دائماً
وسيلتها.
ولم
أستمع
إلى
نداء
يشغلني
عن
العالم
كما
يفعل
الكتاب.
وعادةً
ما
يحدث
لي
مع
الكتاب
مسٌّ
يشبه
هيام
العشاق.
ففي
معرض
الكتاب
الذي
دارت
تفاصيل
مسرحيته
قبل
أيام
لم
أكن
مدعواً
إلى
المعرض،
ومع
ذلك
فقد
ذهبت،
وفاءً
مني
لهذا
العشق
والمرض
الأبدي.
يوم
افتتاح
معرض
الكتاب
يتغير
شكل
الحياة،
يصبح
لون
السماء
أخضر،
والجدران
والواجهات
مائية،
ليس
فيها
ما
يشير
إلى
أنها
حواجز
تمنع
الرؤية،
يصير
العالم
أكثر
جمالاً،
والعصافير
في
أتم
انتشائها
وبهجتها،
وأنا
بين
الحزن
والأمل.
وقف
حراس
المعرض
مثل
مصدات
السيول
التي
تمنع
تدفق
الماء؛
لكنهم
كانوا
يسمحون
لمن
ليس
لهم
علاقة
بالكتاب
بالمثول
بين
يدي
الأرفف.
وعندما
طال
انتظاري
في
الوقوف
ذهبت
عيناي
إلى
الأمكنة
البعيدة،
حيث
أغلفة
الكتب
المصقولة
تتراشقني
بكل
خبث.
لحظتها
سقط
من
بين
يدي
هاتفي
المحمول
وتفتت
إلى
قطع
صغيرة،
وخرت
حقيبتي
مغشياً
عليها،
وتناثرت
أوراق
وأحلام
كثيرة
في
الهواء.
وطوال
أيام
المعرض
ظللت
أحلم
بأنني
قرأت
ذلك
الكتاب،
وذلك
أيضاً...
إن
هذه
المشاعر
الحميمة،
التي
ما
زال
الكتاب
يشغلها
ويعتلي
عرشها،
هي
في
الحقيقة
دليل
واضح
على
أن
الكتاب،
المخطوط
أو
المطبوع
ما
يزال
متربعاً
على
عروش
الأفئدة
والأنامل،
وأن
منافسة
الكتاب
الإلكتروني
لم
تصل
بعد
إلى
أدنى
مستوياتها.
ولا
شك
أن
الكتاب
المطبوع
سيعيش
عمراً
أطول
بكثير
مما
نتوقع.
وستظل
علاقة
الكتاب
المطبوع
والكتاب
الإلكتروني
تشبع
التعليم
عن
قرب
والتعليم
عن
بُعد؛
لأن
حضور
الكتاب
بروحه
وجسده
بين
يدي
القارئ
يمثل
حالة
واقعية
ملموسة.
ويفعل
الكتاب
المطبوع
في
القارئ
ما
يفعله
الممثل
على
خشبة
المسرح
فأن
ترى
الممثل
وأنت
في
مواجهته
ليس
كمن
يراه
وهو
على
الشاشة
الفضية
مثلاً؛
هناك
فرق.
إذا
كان
الكتاب
يفعل
بالقارئ
كما
يفعل
الساحر
بمسحوره،
فإنني
أرى
جملة
من
النقاط
التي
لا
بد
أن
يأخذها
معدو
معارض
الكتاب:
-
أن
يعي
القائمون
على
المعرض
أن
معرض
الكتاب
هو
الفرصة
الذهبية
أمام
المثقف
اليمني،
وأن
من
واجبهم
محاولة
إشراك
الجميع
في
فعاليات
المعرض
وفي
التحضير
له
وفي
صوغ
أفكاره
الرئيسة
والأهداف
المنشودة
منه،
وألا
ينتهي
المعرض
دون
تحقيق
الجزء
الأكبر
من
الأهداف
المرتجاة.
-
إزالة
القطيعة
المستمرة
بين
المعارض
السابقة
واللاحقة؛
لأن
ما
يحدث
في
الواقع
يدعو
إلى
الغرابة؛
فبدلاً
من
أن
يتطور
الأداء
لمعارض
الكتاب
نلحظ
أن
الأداء
يتردى
عاماً
بعد
عام؛
وذلك
بسبب
غياب
المثقفين
عن
فقرات
الإعداد
والبناء،
ويؤدي
ذلك
إلى
فقدان
المكاسب
التي
كانت
لصالح
المبدع
في
المعرض
السابق.
-
يعتقد
البعض
أن
معرض
الكتاب
فرصة
حقيقية
للربح
والإثراء،
وهو
في
الحقيقة
على
العكس
من
ذلك؛
إنه
فرصة
للتضحية
والبذل،
والمصالحة
والتسامح.
فلا
يعقل
أن
يصل
الكتاب
إلى
فئة
من
الناس
ولا
يصل
إلى
الفئة
الأخرى
الأقل
فقراً،
وهي
فئة
المهتمين
بالثقافة
والكتابة
والاطلاع
والبحث.
-
هناك
ملاحظة
جوهرية،
وهي
أن
قيمة
الكتاب
لا
تتناسب
مع
الدخل
المحدود
للموظف،
ولا
بد
في
هذه
الجزئية
من
العمل
على
معالجة
هذا
الخلل،
الذي
ربما
يعود
لأسباب
غير
معلنة،
كالجمارك
والشحن
وأجور
المعرض
وما
شابه
ذلك.
-
محاولة
إشراك
جميع
دور
النشر
العربية
والعالمية،
وخاصة
ذات
العلاقة،
والمشهود
لها.
-
أن
يكون
معرض
الكتاب
انعكاساً
للواقع
الثقافي
والسياسي
والتاريخي،
وهو
الأمر
الذي
يستدعي
فعاليات
مصاحبة
جادة
تكون
بحجم
هذا
الموروث
الثقافي
والتاريخي،
بحيث
يتم
إبراز
القدرات
الجديدة
والشابة
الموجودة.
-
تجاوز
الكتب
التقليدية
التي
تعمل
على
تسطيح
الوعي
وخلق
جيل
بعيد
عن
العصر،
جيل
يعيش
في
القرون
الأولى
للهجرة؛
لأن
هذه
الكتب
ستؤدي
إلى
انحراف
في
الوعي.
-
التفكير
جدياً
بتوصيل
وهج
المعرض
إلى
بقية
المحافظات
اليمنية،
وذلك
من
أجل
خلق
نهضة
علمية
وثقافية
واجتماعية
حقيقية.
*
معارض
الكتاب
وجدوى
التنظيم
محمد
عبد الوهاب الشيباني
 منذ العام 2003 وأنا
متواجد في معرض
صنعاء للكتاب
بصفتي مشاركاً، من
خلال جناح
اتحاد الأدباء والكتَّاب
اليمنيين. وعلى
مدى 15 عاماً
تقريباً -سابقة
لفترة المشاركة-
عرفت
معرض صنعاء كزائر
دائم... هذا
المعرض بدأت
باحتضانه جامعة صنعاء
إبان رئاسة
الدكتور عبد العزيز
المقالح لها،
قبل أن تتولى
مهمة تنظيمه
وزارة الثقافة، ومنذ
أربع سنوات
تقوم بتنظيمه الهيئة
العامة للكتاب.
الاختراق (التنظيمي)
الوحيد
كان في العام
1997؛
إذ تولى "النادي
الأدبي" (كيان
أطلقه المؤتمر
الشعبي العام قبل
أن ينطفئ ويغيب
بالسرعة والكيفية
ذاتيهما) تنظيمه
في واحدة من
صالات العرض
التجارية في سوق
عامة. منذ العام 2003 وأنا
متواجد في معرض
صنعاء للكتاب
بصفتي مشاركاً، من
خلال جناح
اتحاد الأدباء والكتَّاب
اليمنيين. وعلى
مدى 15 عاماً
تقريباً -سابقة
لفترة المشاركة-
عرفت
معرض صنعاء كزائر
دائم... هذا
المعرض بدأت
باحتضانه جامعة صنعاء
إبان رئاسة
الدكتور عبد العزيز
المقالح لها،
قبل أن تتولى
مهمة تنظيمه
وزارة الثقافة، ومنذ
أربع سنوات
تقوم بتنظيمه الهيئة
العامة للكتاب.
الاختراق (التنظيمي)
الوحيد
كان في العام
1997؛
إذ تولى "النادي
الأدبي" (كيان
أطلقه المؤتمر
الشعبي العام قبل
أن ينطفئ ويغيب
بالسرعة والكيفية
ذاتيهما) تنظيمه
في واحدة من
صالات العرض
التجارية في سوق
عامة.
ما أريد قوله
أن معرض صنعاء
شهد من
التحولات الشيء الكثير،
فبعد أن كانت
تتسابق على
الاشتراك فيه كبريات
دور النشر
العربية المعروفة وتحرص
بعض الدول على
المشاركة الفاعلة
فيه، غدا اليوم
البحث فيه عن
منشورات ومطبوعات
دور شكلت
عناوينها عند الكثيرين
الرافد والمكون
الأساس، كالبحث عن
فقيد غالٍ، في
مساحة محتشدة
بكل شيء سوى
ما تبحث عنه. فليس
لدار الآداب -على
سبيل المثال-
ولا
لدار توبقال من
معروض واحد حتى
ضمن توكيلات
المكتبات المحلية، ولا
الدور المشاركة
فهاتان الجهتان –عندي
وعند كثيرين-
استطاعتا
من خلال
عناوينهما وإصدارتهما خلق
حالة قرائية
متقدمة للآداب والخطاب
الثقافي الجديد
بشكل عام.
حتى أن
الكثير من الدور
المهمة والتي
رفعت أسماءها على
أجنحة المعرض
لم يكن حضورها
إلا من خلال
عناوين غالباً
ما كانت مكدسة
في مخازن
عارفين يعملون كوسطاء
ينتقلون بهذه
العناوين في معارض
لا تتحمس هذه
الدور للمشاركة
فيها، والتي تتسيد
فيها الجهات
"السلفية" مساحات العرض،
بكتبها المجلدة
وسيديهاتها ووسائطها التقنية،
حاشرة الدور
الجادة والجديدة في
زوايا مهملة
وقصية، أو إزاحتها
إلى الملحق،
كما حدث في
هذه الدورة،
حين عرضت دور
الساقي ورياض
الريس والجمل وكلمات
عربية في ملحق
المعرض. وعادة
ما تتم هذه
الإزاحات والإقصاءات
من خلال
الاستحواذ على ساحات
عرض شاسعة في
قلب المعرض.
بالمصادفة كنت أسال
أحد العاملين
في المصنفات الفكرية
بوزارة الثقافة
عن المعرض، فقال
إن أقل ما
يوصف به هذا
المعرض أنه
"إرهابي". إن
تنظيم معرض
صنعاء للكتاب سنوياً
يعد ذاته فعلاً
ثقافياً بامتياز؛
إذ يستطيع فيه
الكثيرون الحصول
على مبتغاهم من
الكتب التي لا
تحضر إلا في
المعرض؛ ومناسبة
أيضاً للعارضين
والكتّاب وأصحاب المكتبات
لإتمام منافعهم
في تسويق الكتاب
وديمومة حضوره؛
غير أن الخوف
من أن يكون
قد أصيب بحالة
شيخوخة تستوجب
معه الحالة أن
تقف الجهات
المعنية (المؤسسات
الثقافية الرسمية
والأهلية)
بمسؤولية أمام
مخرجات المعرض؛
فليس المهم أن
تحشد مئات
الأسماء والعناوين تحت
سقف واحد،
الأهم هو:
كيف تجعل من
هذه المناسبة
ينتظرها الجميع في
الداخل من
الزوار وفي الخارج
من أصحاب دور
النشر بكل شوق؟
* * *
جدوى معارض
الكتاب تتحقق من
خلال تلك
المنفعة التي تحققها
لطرفي المعادلة: العارض،
والزائر؛ لتصب
في النهاية في
خانة صناعة
الكتاب وتسويقه.
واعتماداً
على قاعدة مثل
هذه فإن الجدوى
سوف تتفاوت من
معرض لآخر...
فمعرض
الكتاب في القاهرة
–وهو
الأول عربياً-
يهيأ
له لتتحول أيامه
إلى تظاهرة
ثقافية كبرى، فالزائر
لا يبحث فيه
عن عنوان كتاب
فقط، بل سيبحث
عن كاتب أو
مؤلف لديه
فعالية، أو سوف
يستمتع بحضور
ندوة ما، أو
مشاهدة عروض
مصاحبة... إلخ،
فالجدوى ستكون
هنا من تعدد
البدائل التي
يتيحها العرض، وكذا
استهدافاته الخدمية
المتعددة.
أخلص إلى القول: إن
الجدوى متحققة
أصلاً وبنسب متفاوتة
في المعارض
كلها، ويجيء على
رأسها تلك
الاستمرارية في تنظيم
وإقامة المعارض
الخاصة بالكتاب في
وقت أصبح فيه
مقاربة المعرفة
فعلاً بائساً؛ والسبب
هو تعظيم قيمة
الاستهلاك واللهاث
المحموم وراء
تفاصيل المعاش ومكابداته
التي لا تنتهي.
*الكتاب..
غياب
أم
استراتيجية
حضور
... رؤية
مقارنة
نبيل
عبادي
 إذا
كانت
الهيئة
المصرية
العامة
للكتاب،
ولم
تزل،
هي
الأم
الرؤوم
التي
ترعى
الكتاب
في
العالم
العربي،
وهي
التي
بلغت
من
الحرص
حداً
جعلها
تصل
به
إلى
المستوى
اللائق
بمكانته
وأهميته
على
الصعيدين
المحلي
والعالمي،
فضلاً
عن
دورها
الحيوي
في
تقديم
الأرصدة
الأصيلة
لأمهات
الكتب
العربية
والأجنبية
في
مختلف
فروع
المعرفة،
وهي
التي
يسّرت
على
القارئ
الحصول
على
حاجاته
القرائية
من
علوم
وفنون
وآداب،
بإقامة
معرض
القاهرة
الدولي
للكتاب
كنموذج
أول
و"نجم"
للحالة
العربية،
أضحى
منارة
للمعرفة
ومنتدى
تُشد
إليه
الرحال
في
كل
دورة
جديدة
له،
ولعله
خلال
العام
الحالي
قد
بلغ
من
عمره
التسلسلي
الـ41
وهو
رصيده
من
التراكم
الاستراتيجي
والمؤسسي
بأجندته
وسلالته
الثقافية
والإبداعية
المتنوعة
والمختلفة
وثراء
سياساته
وخارطته
التي
تستوعب
الأفكار
والعناوين
وتركز
على
التثاقف
مع
الآخر
كمعرض
له
تاريخ؛
فماذا
يمكننا
أن
نقول
بعد
ذلك
في
حال
الحديث
عن
معرض
صنعاء
الدولي
الذي
وصل
هذا
العام
(2009)
إلى
أسوأ
مراحله
على
صعد
كثيرة،
رغم
وصوله
إلى
ما
يقرب
من
عقده
الثالث. إذا
كانت
الهيئة
المصرية
العامة
للكتاب،
ولم
تزل،
هي
الأم
الرؤوم
التي
ترعى
الكتاب
في
العالم
العربي،
وهي
التي
بلغت
من
الحرص
حداً
جعلها
تصل
به
إلى
المستوى
اللائق
بمكانته
وأهميته
على
الصعيدين
المحلي
والعالمي،
فضلاً
عن
دورها
الحيوي
في
تقديم
الأرصدة
الأصيلة
لأمهات
الكتب
العربية
والأجنبية
في
مختلف
فروع
المعرفة،
وهي
التي
يسّرت
على
القارئ
الحصول
على
حاجاته
القرائية
من
علوم
وفنون
وآداب،
بإقامة
معرض
القاهرة
الدولي
للكتاب
كنموذج
أول
و"نجم"
للحالة
العربية،
أضحى
منارة
للمعرفة
ومنتدى
تُشد
إليه
الرحال
في
كل
دورة
جديدة
له،
ولعله
خلال
العام
الحالي
قد
بلغ
من
عمره
التسلسلي
الـ41
وهو
رصيده
من
التراكم
الاستراتيجي
والمؤسسي
بأجندته
وسلالته
الثقافية
والإبداعية
المتنوعة
والمختلفة
وثراء
سياساته
وخارطته
التي
تستوعب
الأفكار
والعناوين
وتركز
على
التثاقف
مع
الآخر
كمعرض
له
تاريخ؛
فماذا
يمكننا
أن
نقول
بعد
ذلك
في
حال
الحديث
عن
معرض
صنعاء
الدولي
الذي
وصل
هذا
العام
(2009)
إلى
أسوأ
مراحله
على
صعد
كثيرة،
رغم
وصوله
إلى
ما
يقرب
من
عقده
الثالث.
لقد
درجنا
في
اليمن،
وربما
في
غير
بلد
من
العالم
العربي،
على
الاستغراق
طويلاً
في
البحث
عن
المخلص
في
كل
شيء،
وعن
الحديث
عن
النموذج
في
محيطنا،
والزهو
به،
حدّا
بلغ
من
الشوفينية
القومية
شأوا
لا
يطاق،
تماماً
مثلما
بقينا
لعقود
نردد
مثلاً:
"مصر
أم
الدنيا"،
فهي
الأولى
في
إنتاج
الثورة
العربية
الأم،
والأولى
في
السكان،
والنموذج
الذي
سلك
في
نظرته
حد
عبادة
الأمكنة
كشواهد
للحضارة
في
حين
تمت
اللامبالاة
في
النظر
إلى
إنسان
يطحن
على
الواقع
لأمتنا.
فمصر
مثلا
بقيت
في
البال
هي
الأولى
في
السينما،
وإن
على
صعيد
الكم،
وفي
الفن
والرواية.
وهي
كذلك
الأولى
عربياً
حتى
في
الجريمة،
حسب
ما
تطالعنا
به
صحف
الحوادث
المتخصصة
والتي
صار
لها
مراسلون
بمهنية
أيضا
في
غير
بلد
وصحيفة
عربية
أو
مجلة.
لقد
بقي
انشدادنا
طويلاً
كعرب
وكيمنيين،
بخاصة
عند
الوقوف
فحسب
على
"الثوابت"،
لكن
دون
إعطائها
مساحتها
الجوهرية
في
المفهوم،
وتنمية
هذا
الأخير
في
نسق
الجامعة
والتعليم
بشكل
عام.
كأن
تتحول
الفكرة
التي
تختزل
معطى
التغيير
في
شكل
رؤى
يمكن
تحويلها
إلى
مؤسسة
قائمة
بذاتها،
لا
على
معطى
التجريد
الذي
يغيب
المفهوم
من
خلاله
ويصار
إلى
ضباب
في
الرؤية
وفي
الموقف
من
الحياة
وإنسانها.
وفي
حين
أن
البقاء
عند
الثبات
إزاء
تأمل
نموذج
واحد،
عملنا
على
تنميط
أسلوب
حياتنا
وطرق
تفكيرنا
في
علاقتنا
بأنفسنا
أولاً؛
ما
أفضى
بدوره
إلى
إنتاج
ما
يشبه
كتاب
الموت
لا
كتاب
الحياة،
لكن
دونما
تفكير
في
وضع
استراتيجية
تنمية
ثقافية
شاملة
وواضحة
لحاضر
نعيشه
برافعة
ماض
ملتبس.
فلا
خطط
مستقبلية
تستهدف
وعي
الأفراد
بالتنمية
البشرية
بمستوياتها
وأبعادها،
ولا
إشباع
لحيزات
فراغ
واسعة
بقيت
شاغرة
في
حياتنا
ومعزولة
وما
تزال
عن
معنى
القراءة
والارتباط
الحميم
بالكتاب
كعلاقة
حضارية
يعوزها
التربية
حتى
على
كيفية
التصفح
والإمساك
به،
مروراً
بالنظر
إلى
تعيين
تلك
الرغبة
المؤجلة
لمشاريع
كثيرة
وأدناها
مثل
توريد
مبالغ
خيالية
لبعض
الهيئات
إلى
خزانة
المال
بأساليب
غامضة
بسبب
فساد
تلك
الجهات
وعجزها
عن
وضع
استراتيجية
مشاريع
أو
رؤى
يمكن
بالطبع
أن
تحقق
ولو
بعض
حاجات
المجتمع
الماسة
للتنمية
المقترنة
ببناء
الإنسان
لا
العمارات.
وكل
ذلك
يحدث
في
ظل
غياب
أي
استراتيجية،
ونتيجة
لإخضاع
الوظيفة
العامة
غالبا
لمزاج
أفراد
يعطلون
مصالح
مجتمعات.
كما
لا
يكاد
يحضر
الوعي
المعرفي
للفرد
كواجب
ويقظة
مطلبية
وخيار،
بل
وضرورة
ماسة
للتحول
والتفاعل
في
نسق
المجتمع
وعلاقته
بالثقافة.
غير
أن
الكتاب
بقي
معزولا
في
غيابة
المخازن
ولم
يتأسس
في
الحالة
اليمنية
ربما،
وبخاصة،
لجهة
ارتباطه
بفكرة
تحول
ما
يحضر
كقيمة
متراكمة
على
صعيد
الأخذ
به
كجدوى
واستنتاج
بحث
ودراسات
ومسح
متعلق
برقية
الثقافة
في
المجتمع.
والكتاب
بهذا
المعنى
وكوسيلة
ووعاء
للمعرفة
السمع
بصرية،
مازال
قيمة
لم
يتأسس
حضورها
كما
نجده
في
دول
ونماذج
بعينها
انطلقت
من
قروسطيتها
إلى
عهود
أنوار
جديدة
وتحولات.
فإلى
أي
مدى
ستبقى
خيارات
التحول
المشروع
بعيدة
عنا
ولا
نلمسها
سوى
في
شكل
خطاب
ترفيهي
متخلف
وهشاشة
تدير
حياتنا
التي
يحتكرها
أفراد،
وبإدارة
لا
تعي
معنى
الإدارة
بأفق
"المستقبل
الأفضل"،
ولا
هي
أيضا
تقدر
معطى
المعرفة
والعلم
برافعة
الكتاب
وتحويله
إلى
مؤسسة
وعي
تنتظم
بنية
الفرد
الذهنية
وتصفيها
من
شوائب
الأيديولوجيا
وأصوليات
"النفط
لوجيا".
غير
أنه
ورغم
العوامل
الاجتماعية
والاقتصادية
المصاحبة
والعرف
المتراكم
من
تقويلات
رثة
تمارس
في
أحايين
كثيرة
قدرة
سلبية
وخطيرة
في
التعطيل
داخل
نسيج
الخطاب
الثقافي
للمجتمع
وتعزله
تارة
عن
رغبة
التفاعل
والاستجابة
لكل
تحول
طبيعي؛
فإن
النداءات
باتجاه
ثقافة
المجتمع
المدني
والمفاهيم
المشابهة
في
سياقه،
كتحولات،
بقيت
بطيئة
جداً
ولا
نجد
في
الحقيقة
ما
نلمسه
منها
على
الواقع
سوى
ظل
الشعار،
بقدر
ما
بقي
تعشقنا
لنغمات
انتهت
على
صعيد
قومي،
وبقيت
فكرة
تنمية
الداخل
والوطني
مستلبة
ومعزولة
بعوامل
شمولية
النظرة،
حرمنا
من
خلالها
أن
أنعيش
فكرة
الكتاب
والمعرفة
كحاجة
مفاهيمية
داخلية
ومن
ثم
كتأمل
ذاتي
تماما،
مثل
أن
نكتب
قصيدة
أو
نربي
طفلا،
كشأن
يتعلق
بالبيت
وترتيبه.
وهكذا
بقي
الطموح
مستلبا
في
عقولنا
لفكرة
تقادمت
وتعاظمت
إلى
أن
صغرت
وتلاشت
كشأن
اجتماعي
بالدرجة
الأولى.
وهو
ما
يمكن
أن
أُسميه
"خصخصة
فكرة
التحول
عبر
الثورة"،
وتحويل
الأخيرة
إلى
خيار
يتبع
القطاع
الخاص
لا
العام.
كل
هذا
تم
بإرادة
عسكرة
الثقافة
والإبداع
وثقافة
الاستبداد
والاستيهام
السياسي
والإعلامي،
إن
لم
أقل
بعسكرة
فكرة
الثورة
الثقافية
نفسها
واستدراكها
كخطأ
يمكن
أن
يهدد
الفرد
في
الأعلى،
بدلاً
من
بلورتها
كاستراتيجية
تحول
حقيقي
ونشدان
تغيير
لمجتمع
القاع.
وما
يبدو
للبعض
أنه
تحقق
ثقافيا
كإنجاز
لا
يتمثل
في
مؤسسة
الكتاب،
لا
يمكنه
سوى
أن
ينتظم
كصورة
(إعلانية)
على
حائط
الانتخاب،
كما
على
صعيد
تكاثر
الظاهرة
باتجاه
الكمي
لثقافة
المبنى
على
حساب
المعنى
وتغييبه.
وأعني
بالمعنى
هنا
ما
يمكنه
أن
يتمثل
في
نسق
الاهتمام
بشؤون
استراتيجية
إنهاض
المجتمع
المدني
وتنمية
الحرية
والتعددية
بين
أفراده،
بمعايير
ثقافة
وصناعة
الكتاب
وطبيعة
رؤية
هيئاته
بمسؤولية،
وضرورة
تحقيق
المعايير
المتقدمة
كشرط
للتنافس
وإثبات
معطى
وجودي
معرفي
بين
الأمم
الأخرى
لحضورنا.
فمصر
مثلا
بقيت
هي
الأفق
الذي
تحدق
باتجاهه
طموحاتنا
في
كل
تفاصيل
وسمات
حياتنا
العشوائية
منذ
عقود،
بدءاً
من
حصة
البلاغة،
وانتهاء
باستنساخ
فراعنة
في
هيئة
أقيال
يلتقون
تاريخيا
في
تعاليم
ومسودات
(السخرة)
في
علاقتهم
بالمجتمع،
لكن
دونما
تحقيق
أي
سمة
للتميز
ولو
في
الإطار
القومي
سوى
بصناعة
الحروب،
واستبدالها
بما
يشبه
خططاً
مستدامة
لتنمية
مصالح
ضيقة.
وهكذا
بقي
حالنا
في
تأخر
دائم
ودون
تقييم
أو
رؤية؛
وربما
لأننا
لا
نريد
ذلك
لأنفسنا،
كما
لا
نرغب
ربما
أو
نقبل
حتى
نشر
مجرد
رأي
أو
وجهة
النظر
هنا
أو
هناك،
بالرغم
من
أنها
بالطبع
ليست
مسدسا،
بل
كلمات
ودلالات
في
معان
سلمية
قد
تتلمس
الأحوال.
غير
أن
حالا
نعيشه
لا
يكاد
يتقدم
على
صعيد
المفهوم
أو
الفكرة
العليا
لافتراض
المتغير
في
ثباته،
لا
على
صعيد
تحولات
طرأت
على
صعيد
معرض
صنعاء
الدولي
للكتاب
مثلاً،
وبخاصة
من
تسلسله
ما
فوق
الرقم
17،
أي
بعد
أن
فقد
ما
يشبه
تنظيمه
المؤسسي
برافعة
الجهة
الأكاديمية،
وكانت
تلك
تمثل
الخطوة
والحسنة
الوحيدة
ربما
للجامعة
الأولى
في
اليمن
(جامعة
صنعاء).
أما
اليوم
فقد
تكاثرت
الهيئات
والفساد
وأحد
هيئات
تسير
دون
استراتيجية
سوى
الطموح
في
إدارة
مبنى
أو
الإشراف
على
مساحة
من
أرض
مخصصة
كعنوان
لحضارة
كتاب،
يمكن
أن
تتصدق
بتمويل
مأوى
له
الصين
الشعبية؛
لأننا
في
الحقيقة
لا
نهتم
بأي
شيء
سوى
بتنمية
اللامبالاة
حتى
غدت
مؤسسة
فوضى.
ولم
يغدُ
التفكير
على
صعيد
الحقوق
مطلبا
لوعينا
في
المطالبة
والاقتراح،
وبالتالي
بدافع
فكرة
الاحتياج
والضرورة
في
المسايرة
أو
التواكب
الحضاري
مع
العالم
اليوم؛
وعبر
نسق
المفاهيم
والمعرفة
التي
تدخل
ضمن
التعليم
ككتاب
مقرر،
وبأفق
الصورة،
متخففاً
من
ثقافة
المحفوظات
التي
عملت
على
تبلد
وعي
أجيال.
والأجدى
هو
البحث
عن
آلية
أخرى
تعمل
على
تطور
بناء
وعي
وتنمية
مجتمعنا.
وبدون
الرغبة
في
ذلك،
ومن
ثم
الإرادة
الأخلاقية
والسياسية
في
التغيير،
وإعادة
النظر
بمراجعة
أمور
كثيرة؛
سيظل
مآل
حياتنا
وأحوالنا
في
مراوحة
بين
السيئ
والأسوأ،
وستبقى
الرغبة
ناقصة،
لغياب
الفعل
الحياتي
للعقل
وضرورة
التفكير
قبل
الكلام.
لنعمل
-إذاً-
على
أن
تبقى
رغباتنا
تنافس
للوصول
في
تحقيق
تقدم
المعطى
الثقافي
فيما
يتعلق
بالكتاب
اليمني
والإبداع
بشكل
عام،
كما
على
صعيد
طباعته،
وتحري
نوعية
مضامينه،
وأنسنة
معايير
التعاطي
في
انتشاره،
إلى
جانب
إخراجه
فنياً
بخفة
تشي
بالتعاطي
مع
الكتاب
كحياة
وطقوس
متبادلة
من
الخفة
والمعايشة
والإحساس
بالكتاب
كإنسان
وصديق
حميم
بيننا،
وتجربة
وازنة
لضبط
قدرتنا
على
التفكير
السليم
والمعرفة
العاقلة
بالعلم،
وليس
بثقافة
الخرافة.
من
هنا
يمكن
أن
تتبلور
رؤية
حقيقية
تستوعب
المتحول
باتجاه
الإنسان
في
اقترانه
بالمعرفة
وبالقراءة
المتراكمة
في
علاقتها
بالكتاب
قبل
إنتاجه
أو
صناعته
ومن
ثم
فن
إخراجه
للناس
بأفق
بصري
مغرٍ
لشاشة
التلقي،
وبحرص
على
تنمية
ذائقة
تنتظر
الشغف
بتفاعل
المجتمع
وردم
الهوات
بتجسير
الثقافة
ورؤية
المستقبل،
كما
بالنظر
إلى
حجم
التحديات
الراهنة،
ليتسنى
للجهات
المعنية
تقييم
أخطائها
والاعتراف
بوجود
مشكلة
أولاً،
كي
تتوافر
مصداقية
العمل
في
استشعار
دعم
قيمته
وصناعته
وتحريره
من
أغلفة
الذهب،
والعمل
على
تنمية
استراتيجية
حضوره
بالعمل
على
توافره
وازدهار
مجالاته
في
الدراسات
والبحوث
ومستويات
وأجناس
الأدب
والفكر
والفلسفة،
والتفاعل
معها،
على
صعيد
تيسير
اقتناء
وسيلة
العلوم
الحضارية
المرتبطة
بلحظة
تقدم
الإنسان
بالمعرفة
وإشاعتها
بكل
الأساليب،
كهواء
متطلب
للكائن
في
الحياة
والنمو
الطبيعي
والمعرفي
للمجتمع
بمستويات
مختلفة
وإيجابية
من
شأنها
أن
توصل
ولو
متأخراً
إلى
سلم
الرقي
وحضارة
الكلمة.
*
غياب
الأهداف
وغياب
صناعة
الكتاب
محي
الدين جرمة
 ينبغي
أن
تهتم
معارض
الكتاب
بعرض
ما
هو
جديد
من
الإصدارات،
وهو
ما
نراه
في
عدد
من
معارض
الكتب
في
دول
مختلفة
من
العالم،
فمثلاً
معرض
الكتاب
في
سنغافورة
يضم
أجنحة
دور
نشر
تعرض
نماذج
من
إصداراتها
الجديدة
تُعّرف
بها،
ليس
فقط
للقارئ،
ولكن
كذلك
-وهو
الأهم-
للموزعين
والمكتبات
في
داخل
ذلك
البلد
وخارجه. ينبغي
أن
تهتم
معارض
الكتاب
بعرض
ما
هو
جديد
من
الإصدارات،
وهو
ما
نراه
في
عدد
من
معارض
الكتب
في
دول
مختلفة
من
العالم،
فمثلاً
معرض
الكتاب
في
سنغافورة
يضم
أجنحة
دور
نشر
تعرض
نماذج
من
إصداراتها
الجديدة
تُعّرف
بها،
ليس
فقط
للقارئ،
ولكن
كذلك
-وهو
الأهم-
للموزعين
والمكتبات
في
داخل
ذلك
البلد
وخارجه.
أما
في
معرض
لندن
الدولي
للكتاب
فتتسابق
دور
النشر
من
مختلف
دول
العالم
في
عرض
نماذج
من
أحدث
إصداراتها،
وتستهدف
بذلك
عقد
صفقات
التوزيع
والترجمة
والتبادل
مع
ناشرين
آخرين
من
مختلف
دول
العالم.
وبالإضافة
إلى
ذلك
هناك
قسم
كامل
من
المعرض
يحمل
عنوان
"متبقيات"،
تعرض
فيه
دور
النشر
والموزعون
ما
تزخر
به
مخازنهم
من
عناوين
كتب
تبقت
من
السنوات
السابقة
وتباع
هنا
بسعر
مخفض
وبالجملة،
وهي
بهذا
لا
تستهدف
القارئ
الفرد
بقدر
ما
تستهدف
أصحاب
المكتبات
والموزعين
الذين
يزورون
معرض
لندن
لهذا
لغرض.
أما
معرض
فرانكفورت
فيعد
السوق
الأساسية
للكتاب
وبورصته
الفاعلة،
حيث
تحرص
دور
النشر
من
مختلف
دول
العالم
شرقه
وغربه،
شماله
وجنوبه،
عدا
قلة
من
الدول
المختلفة
ومنها
اليمن
،
على
المشاركة
وعرض
أحدث
إصداراتها،
واصطحاب
مؤلفي
ومصممي
ورسامي
بعض
تلك
الكتب
إلى
أروقة
المعرض
وأجنحته،
ليتعرفوا
على
أحدث
وسائل
الإصدار،
وليتعرف
عليهم
الآخرون،
في
محاولة
لعقد
صفقات
التبادل
والترجمة
والتوزيع.
كل
هذا
التفاعل
ينتج
عنه
تدفق
هائل
للمعرفة
في
كل
الاتجاهات.
عندما
تشاهد
كل
هذا
الحراك
في
سوق
الكتاب
العالمية
تدرك
أن
وسائط
المعلوماتية
الإلكترونية
لم
تشكل
منافساً
حقيقياً
للكتاب
الورقي،
فمازالت
عناوين
الكتب
تتزايد
في
اليابان
وبريطانيا
والولايات
المتحدة
وفرنسا،
وحتى
في
اليونان
وأسبانيا
والهند.
ولا
يقتصر
هذا
التزايد
على
الكتب
التقنية،
بل
يشمل
الإنتاج
الإبداعي،
من
قصة
ورواية
وشعر
ومسرح.
ويمكننا
الآن
أن
نصل
إلى
خلاصة
أن
معارض
الكتب
-المصنفة
على
أنها
دولية-
هي
في
الأساس
توجه
لخدمة
المشتغلين
في
مجال
صناعة
الكتاب،
من
مؤلفين
ومترجمين
ومصممين
ورسامين
وناشرين
وموزعين
ووكلاء
ومكاتب
خدمات
ذات
علاقة
في
مجال
النشر
والتوزيع.
ولا
نجد
معارض
الكتب
التي
تبيع
الكتب
بشكل
مباشر
للجمهور
إلا
في
بعض
الدول
(وفيها
جميع
الدول
العربية)
التي
تفتقر
إلى
التواجد
الحقيقي
لصناعة
الكتاب
بها.
وفي
ظل
واقع
الافتقاد
إلى
هيكل
منظم
لصناعة
الكتاب،
ما
الذي
نتوقعه
من
معارض
الكتب
التي
تقام
في
بلادنا،
والتي
يصر
منظموها
-مع
سبق
الإصرار
والترصد-
على
إضفاء
تسمية
"دولية"
عليها؟
فمعرض
دولي
في
صنعاء،
ودولي
آخر
في
عدن،
ودولي
ثالث
في
الحديدة،
ودولي
رابع
في
تعز،
ودولي
خامس
في
المكلا...
وهكذا
يصبح
من
حق
كل
المدن
اليمنية
أن
تطالب
بمعارض
كتب
دولية،
تماماً
كما
حدث
في
المناطق
الحرة،
والمحميات،
ومازلنا
بانتظار
ميناء
ذمار!
لماذا
لا
تكون
لمعارض
الكتاب
في
اليمن
أهداف
محددة
تسعى
لتحقيقها،
وبهذا
يكون
لمعرض
صنعاء
هدف،
ولمعارض
المدن
أهدافها؟
إذ
تعد
معارض
الكتب
الفرصة
المناسبة،
سواء
للقارئ
أم
للناشر
-في
ظروفنا-
للتعرف
على
الإصدارات
الجديدة
في
مختلف
المجالات.
فالزائر
وهو
يتجول
بين
أجنحة
المعرض
يشاهد
ويتعرف
على
ما
صدر
من
كتب
هنا
وهناك،
وكذلك
يفعل
الناشر.
تقام
معارض
الكتاب
لتحقيق
هدفين
رئيسيين،
أحدهما
أو
كلاهما
في
نفس
الوقت:
1.
عرض
الأجد
من
إصدارات
دور
النشر
ومراكز
إنتاج
الكتب.
وهذا
هدف
يمكن
أن
يحققه
معرض
دولي
في
صنعاء.
2.
عرض
مخزون
دور
النشر
من
مختلف
الإصدارات
وتوفيرها
للقارئ
بأسعار
مخفضة،
بل
ومنخفضة
كثيراً،
لتشجيع
الإقبال
على
القراءة.
وهذا
هدف
يمكن
أن
تحققه
معارض
المدن.
|