|
نصوص سردية
قلم أبي
( ) )
همدان دماج
قاص وشاعر
من اليمن.
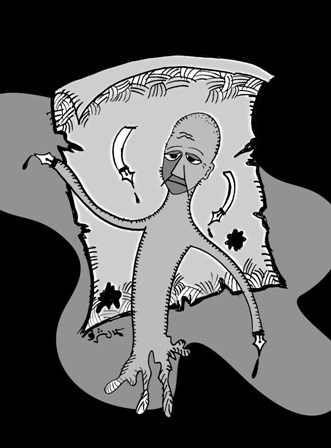 استسلمتُ
أخيراً لليأس، فلا أمل أن أجده هذه المرة..! هكذا أقنعت نفسي على الرغم من أنها
لم تكن المرة الأولى التي أفقده فيها، فقد ضاع مني مراراً وكنت دائماً ما أجده
ولو بعد مدة طويلة. أتذكر أنني في إحدى المرات أضعته ثم وجدته بعد أكثر من عام
بين دفتي كتاب قديم. ومرة أضعته بينما كنت لا أزال أسكن في شقتي القديمة، ثم
وجدته، دون أي تفسير معقول، مرمياً فوق سجادة الصالة في المنزل الجديد الذي
أكتب لكم هذا من إحدى غرفه المظلمة. لا أعرف عدد المرات التي أضعته فيها، لكنها
كثيرة، وكنت خلالها جميعاً واثقاً من العثور عليه في النهاية. لكنني هذه المرة
أدركت أنه ضاع مني إلى لأبد، وأنني لن أجده مرة أخرى؛ ففي اللحظة نفسها التي
تحسست فيها الجيب الداخلي لمعطفي ولم تجد أصابعي القلم فيه استقر غرابٌ أسود
سمين فوق غصن ضعيف لشجرة التين الصغيرة في فناء المنزل، وأطلق نعيقاً مزعجاً
اقشعرّ له جسدي. لحظتها تساءلت: كم مرة حط فيها غرابٌ أسود سمين على شجرة التين
الصغيرة!؟ بل كم مرة رأيت فيها غراباً أسود بمثل هذا الحجم وبهذا القرب!؟ وفي
الحال تولد لدي شعورٌ واضحٌ وقوي بأن القلم قد ضاع مني وانتهى أمره... وبما
أنها المرة الأولى التي أفقد فيها ثقتي بالعثور عليه، والتي يتملكني فيها مثل
هذا الشعور، فقد تعززت لديَّ الثقة المطلقة بأنني لن أجده أبداً. استسلمتُ
أخيراً لليأس، فلا أمل أن أجده هذه المرة..! هكذا أقنعت نفسي على الرغم من أنها
لم تكن المرة الأولى التي أفقده فيها، فقد ضاع مني مراراً وكنت دائماً ما أجده
ولو بعد مدة طويلة. أتذكر أنني في إحدى المرات أضعته ثم وجدته بعد أكثر من عام
بين دفتي كتاب قديم. ومرة أضعته بينما كنت لا أزال أسكن في شقتي القديمة، ثم
وجدته، دون أي تفسير معقول، مرمياً فوق سجادة الصالة في المنزل الجديد الذي
أكتب لكم هذا من إحدى غرفه المظلمة. لا أعرف عدد المرات التي أضعته فيها، لكنها
كثيرة، وكنت خلالها جميعاً واثقاً من العثور عليه في النهاية. لكنني هذه المرة
أدركت أنه ضاع مني إلى لأبد، وأنني لن أجده مرة أخرى؛ ففي اللحظة نفسها التي
تحسست فيها الجيب الداخلي لمعطفي ولم تجد أصابعي القلم فيه استقر غرابٌ أسود
سمين فوق غصن ضعيف لشجرة التين الصغيرة في فناء المنزل، وأطلق نعيقاً مزعجاً
اقشعرّ له جسدي. لحظتها تساءلت: كم مرة حط فيها غرابٌ أسود سمين على شجرة التين
الصغيرة!؟ بل كم مرة رأيت فيها غراباً أسود بمثل هذا الحجم وبهذا القرب!؟ وفي
الحال تولد لدي شعورٌ واضحٌ وقوي بأن القلم قد ضاع مني وانتهى أمره... وبما
أنها المرة الأولى التي أفقد فيها ثقتي بالعثور عليه، والتي يتملكني فيها مثل
هذا الشعور، فقد تعززت لديَّ الثقة المطلقة بأنني لن أجده أبداً.
وقبل أن تعتقدوا أنني أمهد لنتيجة متوقعة ومألوفة، أود أن أقول لكم إنني لم
أعثر على ذلك القلم، تماماً مثل أشياء كثيرة أضعناها ولم نعثر عليها مطلقاً.
لكن أي أهمية يحملها هذا القلم ليستحق أن أكتب لكم عنه؟ حسناً..! إليكم
الحكاية:
كان أبي قد أهداني هذا القلم منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً. لا أتذكر الآن
بأي مناسبة، لكنني أتذكر جيداً أن هذا القلم كان القلم الوحيد الذي أهداني إياه
والدي، بل كان القلم الوحيد الذي تلقيته كهدية طوال حياتي... فكما أتذكر لم يقم
أي شخص بإهدائي قلماً... حتى في ذروة شهرتي ككاتب مرموق كثيراً ما يطل على
قرائه في مقابلات صحفية وبرامج تلفزيونية عديدة، لم يتبادر إلى ذهن أي صديقٍ أو
قارئٍ، أو حتى أحد أصحاب دور النشر التي أتعامل معها، أن يهديني قلماً. كم كنت،
ولا أزال، أتشوق للحصول على قلمٍ كهدية غير متوقعة ومن شخصٍ لم يعرف رغبتي
الجامحة بالحصول على مثل هكذا هدية...! تماماً كما فعل والدي... وقد ألزمتني
هذه الرغبة -بالتالي- بعدم البوح بها مخافة ألا تتحقق، مخافة أن يقوم الناس
بإهدائي أقلاماً تلبية لرغبتي، وبالتالي عدم تحقيقها.
كان القلم ذا هيكلٍ معدني أنيق، فضّي اللون، نحيلاً، ويحمل شارة ماركة أقلام
عالمية معروفة عادةً ما كنت أراها وأنا صغير في إعلانات الجرائد الأجنبية التي
كانت ترسل إلى والدي من معارفه في الخارج. وكان أبي -الذي عُرف كمحامٍ ناجح- قد
أراني كيف أملؤه حبراً، واشترى لي لاحقاً محبرة خاصة، بعد أن لاحظ ازدياد عدد
نقاط الحبر على موكيت غرفته الخاصة التي كنت أختلس لحظة غيابه وأدخلها لأملأ
القلم من إحدى محابره رغم تحذيرات أمي المتكررة.
شُغفت بهذا القلم، وازداد ارتباطي به يوماً بعد يوم، فمنذ أن بدأت استخدامه
لاحظت
-ما لاحظ الجميع- أن خطي بدأ يتحسن رويداً رويدا، وبدأت الدوائر التي كانت
تهيمن عليه تقل يوماً بعد يوم، بل إن أساتذتي بدؤوا يلاحظون تحسناً مطرداً في
مستواي الدراسي وفي كل المواد، خاصة بعد أن صار القلم رفيقي الدائم في
الامتحانات، تلك التي لم تعد تصيبني بالرعب والتي أصبحت أجتازها بكل تفوق.
وهكذا ذاع صيت خطي الجميل، وكان والدي يطلب مني في بعض الأحيان أن أقوم بكتابة
رسائله المهمة، وكنت أقوم بذلك بكل سرور وافتخار. لكن حكايتي مع القلم بدأت
تأخذ منحىً أكثر أهمية عندما لاحظت أن أصابعي تفقد مهارتها عندما تمسك بقلم
آخر، وما تلبث أن تعود إلى رسم دوائر بدلاً من الحروف المنمقة التي كان يرسمها
هذا القلم بكل براعة على صدر الصفحات. ليس هذا فحسب، بل إن تركيزي كان يقلّ؛
وذاكرتي تضعف؛ فقد أكسبني هذا القلم، إضافة إلى الخط الجميل، نشاطاً فكرياً
عالياً وقدرات لغوية متقدمة لاحظت نموها يوماً بعد يوم. وما زلت أتذكر أن أول
مقالة نشرت لي كنت قد كتبتها بذلك القلم، ومنذ تلك اللحظة أصبح القلم هو مصدر
أفكاري وملهمي الوحيد لكتابة المزيد من المقالات التي بدأت أنشرها تباعاً في
عدد من الصحف والمجلات المحلية والخارجية أيضاً. ولم تمض سوى سنوات قليلة حتى
احتفلت بصدور أولى رواياتي التي لاقت صداً طيباً في أوساط النقاد، الذين بدؤوا
يكتبون عني كواحدٍ "من أهم الكتّاب الشباب في بلادنا".
وهكذا أصبح لهذا القلم أهمية كبرى في حياتي. وكنت دائماً ما أحمله معي، أينما
كنت أو توجهت، كأنه حرز خاطته أمٌّ بإحكام على ثياب ابنها الوحيد. عندما توفي
والدي كنت حريصاً على أن يكون القلم بجيب معطفي وأنا أتقدم الجنازة، فقد كان
لذلك أكبر الأثر والمواساة. وفي خضم انشغالي بوتيرة "النجاحات الأدبية" كان
القلق يكبر بداخلي من فقداني لهذا القلم، ولهذا استعملت كل الطرق للاحتفاظ به.
وكم مرة حاولت ترويض أقلامٍ أخرى مشابهة له! لكن دون جدوى، فما إن أتركه حتى
أفقد ثقتي بنفسي وتتغير -سلباً- مجريات حياتي، وبوتيرة سريعة. حاولت أيضاً،
وتحت إلحاح أحد أصدقائي من الناشرين، أن أستخدم الكومبيوتر مباشرة في الكتابة،
لكنني سرعان ما توقفت عن ذلك أيضاً بعد أن شاهدت النتائج الكارثية التي
أحرزتها؛ وكأنَّ القلم كان يرفض أن يكتب أي شيء ركيك، غير مفيد أو غير مدهش،
وما إن أمسك به حتى تنساب الأفكار والكلمات بعذوبة شديدة... حتى أنني كنت عادة
ما أتساءل بخوف داخلي مكتوم: من منا كان يكتب بالآخر!؟
عندما ضاع مني القلم أول مرة شعرت بالهزيمة وتوقفت عن الكتابة، متحججاً
للأصدقاء بأنني تعمدت أن أقضي فترة "نقاهة كتابية" أكمل بها مشاريع قرائية
مهمة. ويبدو أن هذه الكذبة وجدت طريقها للتصديق والإعجاب أيضاً. وخلال تلك
الفترة شعرت بضياعٍ أرعبني، وفقدت تركيزي تماماً، حتى الرغبة في القراءة
فقدتها، وشعرت أنني بالفعل أصبت ببلادة أزعجتني كثيراً. طبعاً كان الحال أفضل
في المرات اللاحقة التي ضاع فيها القلم، إذ حاولت عدم الاستسلام لشعور الضياع
واستغلال الفراغ لترميم ما أفسده نمط حياتي المنشغلة دائماً، فكنت أقوم بزيارات
لأصدقاء لم أرهم منذ فترة طويلة، وبأعمال منزلية روتينية أهملتها، وبدأت أقضي
وقتاً أطول مع زوجتي وأولادي وأفراد أسرتي، الذين تذمروا مرات ومرات من عدم
رؤيتي كما هو الحال مع عائلات وأصدقاء المشاهير. لكنني رغم كل هذا كنت قلقاً
ومهموماً، أنتظر بفارغ الصبر، وبسرّية مطلقة وأمل كبير، عودة القلم إلى
أصابعي.
وها أنا أقص عليكم هذا بعد خمس سنوات من فقداني للقلم... خمس سنوات من اللحظة
التي رأيت فيها ذلك الغراب الأسود السمين الذي حط على شجرة التين في فناء
المنزل لأول مرة... وخلال هذه السنوات -كما ستتوقعون- لم أكتب شيئاً مهماً، بل
لم أكتب أي شيء، ولم أقم بأي عملٍ من أي نوع، فقد عاندتني الكلمات، وتبخرت مني
الأفكار، وتملكني الإحباط، أقضي معظم أوقاتي منعزلاً في غرفتي، أمضغ أوراق
"القات" وحيداً ظهيرة كل يوم بعد أن تناقص عدد الزوار والأصدقاء الذين كان يغص
بهم المقيل من قبل... أمضغ وحدتي وأسفي على نفسي وعليهم... حتى زوجتي فقدتْ
اهتمامها بي رويداً رويدا وانشغلت بالأولاد... والأولاد انشغلوا بمدارسهم...
وأنا لا يشغلني شيء سوى انتظار "معجزة إلهية" أخرى للعثور عليه، ومراقبة
الغربان السوداء التي امتلأ بها فناء المنزل، وبنعيقها المزعج الذي يقض سكون
الجميع، والذي ما تزال جدران الحارة تردد صداه حتى اليوم.
واشنطن - شتاء 2008
|